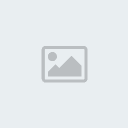1 المبدع المغربي سعيد عاهد:شاعر الدهشة و الانتماء الملتهب الخميس يناير 28, 2010 11:55 am
المبدع المغربي سعيد عاهد:شاعر الدهشة و الانتماء الملتهب الخميس يناير 28, 2010 11:55 am
doukkala
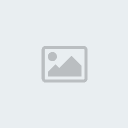
مشرف عام
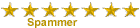
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أحضان دكالة جاءنا الشاعر، من دروب “مازاغان” جاءنا الصحافي، و من تربة المغرب العميق، جاءنا المتعدد في واحد:سعيد عاهد، راغبا في اشتهاء الحقيقة، في اكتناز المعنى و محو الدهشة، أتانا مفتتنا بالقراءة و الانكتاب، يهدينا قصص حب تكتمل أو لا تكتمل، قصص حب معفرة بتراب الأمكنة و زهو الأزمنة، بلغة الضاد، و بلغة موليير أيضا.
لما كان يجرب البحث عن معنى الانتماء، في أحضان مدينة الجديدة تحديدا، بدا له أن يمتشق مسالك المعنى، و أن يتفهم عسر الانتقال من القرية إلى المدينة، مفكرا في أعطاب “ترييف المدن و تمدين القرى”، فكان أن كتب، في مساحات الواجب المدرسي نصا متقدما اختار له من الأسماء: “مشروع دوار حضري” سخطا و ألما على التنمية المعطوبة و التحول المعاق. ذات النص ستفرح به كثيرا أستاذة اللغة الفرنسية، و ستهديه بالمناسبة “الذاكرة الموشومة” للراحل البهي عبد الكبير الخطيبي.
سترافقه ذاكرة الخطيبي، و ستترك وشما بارزا في تقديره للأمور، بل و حتى في قراراته الشعرية اللاحقة، سيعرف أن دكالة/ الهامش/ المنسي، ليست مشروطة بذلك التخمين الماكر المفتوح على استحالة القرع إلى جبن ” كون كانت الكرعة فرماج كون دكالة هي أمستردام” ، لكنها مشروطة برهان السؤال النقدي و الألق الإبداعي الذي أنجب مفكرين و مبدعين كبار من أمثال الخطيبي و العروي و هذا ال “عاهد” أيضا.
لن تصير الجديدة في اعتقاد شاعرنا مجرد “دوار حضري كبير”، بل ستنغرس عميقة في الوعي و الخافق، كمساحة باذخة للإبداع و السؤال، هنا بالضبط ستغدو “الكتابة مدينته”. و سيتأسس القرار الشعري، بما يشبه “القسم” في مدارات المقدس، فقد قرر سعيد عاهد حينها، أن يكون انشقاقه الشعري البكر باللغة الفرنسية، لهذا لم يكن مستغربا أن يكون أول الخطو ديوانا بغير لغته الأم.
من أجل الوفاء بعهده، وجد الفتى نفسه ذات مغرب ملتهب، يعانق الكبار من قارات و سجلات ثقافية و فكرية متعددة و متناقضة، مع انتصار، أعلى قليلا، للشعر “مدرسه قلقه” الأثيرة، سيقرأ كثيرا فاليري، أراغون، مالارميه، دولتو، بودلير، غورتس، ألان، ماركس، لينين، روزا لوكسمبورغ، غرامشي، ألتوسير، جيل دولوز كاتب ياسين، نزار قباني، مهدي عامل، حسين مروة… سيغترف أيضا من المتن الشعبي الذي يتيحه الانتماء إلى مازاغان من انفتاحات مولاي بوشعيب الرداد و مولاي عبد الله أمغار و سيدي عبد الرحمان المجذوب و للا عيشة البحرية…
في مازاغان سيقرأ نصوص المكان المفتوحة، في البحر المطل على اللانهائي، في الأرض التي تحكي أعطاب المغرب القروي، في تاريخ الديانات الثلاث، و سيتعلم بعد حين، كيف يكون الانتماء بلون أحمر، في أزمنة جمر و رصاص لا ينتهي، هنا و الآن سيخلص ل “لاءاته”، و سيرفض الانبطاح أمام قيم الاستهلاك و الاسترخاص، فلا انوجاد له إلا في بهاء و التزام المثقف العضوي.
بعدها قرر ألا يكون صحفيا عابرا، بل ملتزما بالقضية و منتصرا للسؤال، و لو في أزمنة الإجابات الجاهزة، قرر مرة أخرى أن يبحر باتجاه “مهنة المتاعب”، و أن يصير صحفيا ب “ليبراسيون”، لكنه في لحظة ما، سيطلق الصحافة الفرنسية، و المغادرة نحو شقيقتها العربية “الاتحاد الاشتراكي”. و إن كان مفهوما جدا كيف تحقق السفر نحو لغة موليير شعرا، فإنه لحد الآن، لم يتعرف إلا القلة من أصدقائه، على سر بناء هذا القرار المهني، ثمة علبة سوداء عصية التشفير يكتنزها صاحب المحكيات الدكالية.
يوزع اليوم سعيد عاهد “يوميه” بين المدينة الوحش/ البيضاء، و ربيبتها التي تسمى خطأ بمدينة الزهور/ المحمدية، لكنه لا يمنع نفسه من اختلاق الأسباب ليقرئ السلام لمسقط الرأس المتعددة الانتماءات و الخيالات/ الجديدة، و حتى في اللحظة التي يكون فيها بالمحمدية أو البيضاء فإن له في الأولى الصديق العزيز أمان عبد الكريم الذي يذكره بجذوة الانتماء و في الثانية هناك أيضا الرائع سعيد منتسب الذي يمنحه بعضا من هوية مشتركة، فمازاغان حاضرة بثقلها الرمزي و التاريخي في كل انغلاق/ انفتاح ممكن.
يقترح علينا سعيد عاهد دوما السفر في ملكوت الحرف و السؤال، عبر نصوص عابرة لقارات القول، و تيمات عصية على التجنيس، و مفارقات فادحة ماكرة، يأخذنا عنوة إلى أشعار و محكيات و ترجمات و متابعات و مقالات صحفية، تحكي عن “موتنا” و ضياعنا، تفرح بحبنا و انتمائنا، تتواطؤ مع انتظاراتنا و انكساراتنا، و فوق ذلك كله تسرق منا الارتياح البليد، فهذا ال “عاهد” لم يكن يوما من تجار اللغة و لا من عرابيها، كان و لا يزال شاعرا و قاصا و مترجما و صحافيا ألمعيا، يكتب بسؤال و هم وجوديين، أملا في بلوغ المعنى أو اللا معنى.
في “قصة حب دكالية” نكتشف الطفل الذي يسكنه، و الذي لا يستطيع “قتله”، بالرغم من نثر أسراره في محكياته، فسعيد كالطفل في براءته، في حبه، في غضبه، و في انسيابه، ينتقل عبر دروب “مازاغان”، مرتكنا إلى عفو الخاطر و إسعاف الذاكرة، يلتقط تفاصيل الأمس، يعيد تركيبها، من غير تزوير أو تحوير، في أحد عشر انعطاف نحو أسئلة الذات و المدينة و الوطن، نحو مدارات الهوية و الانتماء، نحو جمر الاغتراب و عذابات الانشراخ.
هنا نكتشف الشاعر الذي يتخفى وراء السارد، و المثقف الذي يوجه خيوط الحكاية، نتعرف إلى كاتب رصين يعرف جيدا من أين تؤتى لذة الحكي، و كيف تتأسس جمالية الأضداد، و كيف تصير المحكيات متونا مسافرة في تخوم اللغة و الآداب و العلوم و الفلسفة، و كيف يصير النص المحتمل، نصوصا أخرى و علامات مضيئة، و لا عجب في ذلك فهو المتعدد في واحد، و من الطبيعي أو غير الطبيعي أن تكون محكياته و أشعاره و مقالاته نصوصا متعددة في نص مختلف و مثير للإعجاب.
هذا هو سعيد عاهد، شاعر الدهشة و الانتماء الملتهب، الإبن الشرعي للمغرب الشقي، لهذا كانت نصوصه، و ما تزال، عنوانا لمرحلة من تاريخ مغرب لم يكتب بعد، فهو قبلا و بعدا كاتب استثنائي، غير معني بالظهور السريع، يتردد كثيرا في النشر، تختمر الفكرة عنده لسنوات عدة، يتردد في إطلاق سراحها، يعيد صياغتها من جديد، و حين تكتمل القصيدة، تأسر، تزعج، و تنتقل بقارئها إلى شهود لحظوي مائز.
في أنفاسه الفرنسية، نقرأ شعرا معتقا، لا يكل من تفجير الأسئلة، من مقاومة البداهة، من محاكمة “موت الإنسان” و اغتيال المعنى، و كأنه يستعيد نيتشه و هو يقول “لست مسؤولا عن كل هذا الدمار و الساعة ساعة شك”، لكن عاهد يستشعر المسؤولية بهشاشة الشاعر فيه، بيقظة الصحافي فيه، و بألق المثقف العضوي الذي لا يغادره بالمرة. فموجة التفاهة التي أنتجتها ثقافة “نسخ/لصق”، تجعله يصيح عاليا” هل تنقرض مهنة الكاتب فعلا؟و هل الأنترنيت هو رصاصة الرحمة التي يطلقها أطفالنا على الكتاب؟”
أحضان دكالة جاءنا الشاعر، من دروب “مازاغان” جاءنا الصحافي، و من تربة المغرب العميق، جاءنا المتعدد في واحد:سعيد عاهد، راغبا في اشتهاء الحقيقة، في اكتناز المعنى و محو الدهشة، أتانا مفتتنا بالقراءة و الانكتاب، يهدينا قصص حب تكتمل أو لا تكتمل، قصص حب معفرة بتراب الأمكنة و زهو الأزمنة، بلغة الضاد، و بلغة موليير أيضا.
لما كان يجرب البحث عن معنى الانتماء، في أحضان مدينة الجديدة تحديدا، بدا له أن يمتشق مسالك المعنى، و أن يتفهم عسر الانتقال من القرية إلى المدينة، مفكرا في أعطاب “ترييف المدن و تمدين القرى”، فكان أن كتب، في مساحات الواجب المدرسي نصا متقدما اختار له من الأسماء: “مشروع دوار حضري” سخطا و ألما على التنمية المعطوبة و التحول المعاق. ذات النص ستفرح به كثيرا أستاذة اللغة الفرنسية، و ستهديه بالمناسبة “الذاكرة الموشومة” للراحل البهي عبد الكبير الخطيبي.
سترافقه ذاكرة الخطيبي، و ستترك وشما بارزا في تقديره للأمور، بل و حتى في قراراته الشعرية اللاحقة، سيعرف أن دكالة/ الهامش/ المنسي، ليست مشروطة بذلك التخمين الماكر المفتوح على استحالة القرع إلى جبن ” كون كانت الكرعة فرماج كون دكالة هي أمستردام” ، لكنها مشروطة برهان السؤال النقدي و الألق الإبداعي الذي أنجب مفكرين و مبدعين كبار من أمثال الخطيبي و العروي و هذا ال “عاهد” أيضا.
لن تصير الجديدة في اعتقاد شاعرنا مجرد “دوار حضري كبير”، بل ستنغرس عميقة في الوعي و الخافق، كمساحة باذخة للإبداع و السؤال، هنا بالضبط ستغدو “الكتابة مدينته”. و سيتأسس القرار الشعري، بما يشبه “القسم” في مدارات المقدس، فقد قرر سعيد عاهد حينها، أن يكون انشقاقه الشعري البكر باللغة الفرنسية، لهذا لم يكن مستغربا أن يكون أول الخطو ديوانا بغير لغته الأم.
من أجل الوفاء بعهده، وجد الفتى نفسه ذات مغرب ملتهب، يعانق الكبار من قارات و سجلات ثقافية و فكرية متعددة و متناقضة، مع انتصار، أعلى قليلا، للشعر “مدرسه قلقه” الأثيرة، سيقرأ كثيرا فاليري، أراغون، مالارميه، دولتو، بودلير، غورتس، ألان، ماركس، لينين، روزا لوكسمبورغ، غرامشي، ألتوسير، جيل دولوز كاتب ياسين، نزار قباني، مهدي عامل، حسين مروة… سيغترف أيضا من المتن الشعبي الذي يتيحه الانتماء إلى مازاغان من انفتاحات مولاي بوشعيب الرداد و مولاي عبد الله أمغار و سيدي عبد الرحمان المجذوب و للا عيشة البحرية…
في مازاغان سيقرأ نصوص المكان المفتوحة، في البحر المطل على اللانهائي، في الأرض التي تحكي أعطاب المغرب القروي، في تاريخ الديانات الثلاث، و سيتعلم بعد حين، كيف يكون الانتماء بلون أحمر، في أزمنة جمر و رصاص لا ينتهي، هنا و الآن سيخلص ل “لاءاته”، و سيرفض الانبطاح أمام قيم الاستهلاك و الاسترخاص، فلا انوجاد له إلا في بهاء و التزام المثقف العضوي.
بعدها قرر ألا يكون صحفيا عابرا، بل ملتزما بالقضية و منتصرا للسؤال، و لو في أزمنة الإجابات الجاهزة، قرر مرة أخرى أن يبحر باتجاه “مهنة المتاعب”، و أن يصير صحفيا ب “ليبراسيون”، لكنه في لحظة ما، سيطلق الصحافة الفرنسية، و المغادرة نحو شقيقتها العربية “الاتحاد الاشتراكي”. و إن كان مفهوما جدا كيف تحقق السفر نحو لغة موليير شعرا، فإنه لحد الآن، لم يتعرف إلا القلة من أصدقائه، على سر بناء هذا القرار المهني، ثمة علبة سوداء عصية التشفير يكتنزها صاحب المحكيات الدكالية.
يوزع اليوم سعيد عاهد “يوميه” بين المدينة الوحش/ البيضاء، و ربيبتها التي تسمى خطأ بمدينة الزهور/ المحمدية، لكنه لا يمنع نفسه من اختلاق الأسباب ليقرئ السلام لمسقط الرأس المتعددة الانتماءات و الخيالات/ الجديدة، و حتى في اللحظة التي يكون فيها بالمحمدية أو البيضاء فإن له في الأولى الصديق العزيز أمان عبد الكريم الذي يذكره بجذوة الانتماء و في الثانية هناك أيضا الرائع سعيد منتسب الذي يمنحه بعضا من هوية مشتركة، فمازاغان حاضرة بثقلها الرمزي و التاريخي في كل انغلاق/ انفتاح ممكن.
يقترح علينا سعيد عاهد دوما السفر في ملكوت الحرف و السؤال، عبر نصوص عابرة لقارات القول، و تيمات عصية على التجنيس، و مفارقات فادحة ماكرة، يأخذنا عنوة إلى أشعار و محكيات و ترجمات و متابعات و مقالات صحفية، تحكي عن “موتنا” و ضياعنا، تفرح بحبنا و انتمائنا، تتواطؤ مع انتظاراتنا و انكساراتنا، و فوق ذلك كله تسرق منا الارتياح البليد، فهذا ال “عاهد” لم يكن يوما من تجار اللغة و لا من عرابيها، كان و لا يزال شاعرا و قاصا و مترجما و صحافيا ألمعيا، يكتب بسؤال و هم وجوديين، أملا في بلوغ المعنى أو اللا معنى.
في “قصة حب دكالية” نكتشف الطفل الذي يسكنه، و الذي لا يستطيع “قتله”، بالرغم من نثر أسراره في محكياته، فسعيد كالطفل في براءته، في حبه، في غضبه، و في انسيابه، ينتقل عبر دروب “مازاغان”، مرتكنا إلى عفو الخاطر و إسعاف الذاكرة، يلتقط تفاصيل الأمس، يعيد تركيبها، من غير تزوير أو تحوير، في أحد عشر انعطاف نحو أسئلة الذات و المدينة و الوطن، نحو مدارات الهوية و الانتماء، نحو جمر الاغتراب و عذابات الانشراخ.
هنا نكتشف الشاعر الذي يتخفى وراء السارد، و المثقف الذي يوجه خيوط الحكاية، نتعرف إلى كاتب رصين يعرف جيدا من أين تؤتى لذة الحكي، و كيف تتأسس جمالية الأضداد، و كيف تصير المحكيات متونا مسافرة في تخوم اللغة و الآداب و العلوم و الفلسفة، و كيف يصير النص المحتمل، نصوصا أخرى و علامات مضيئة، و لا عجب في ذلك فهو المتعدد في واحد، و من الطبيعي أو غير الطبيعي أن تكون محكياته و أشعاره و مقالاته نصوصا متعددة في نص مختلف و مثير للإعجاب.
هذا هو سعيد عاهد، شاعر الدهشة و الانتماء الملتهب، الإبن الشرعي للمغرب الشقي، لهذا كانت نصوصه، و ما تزال، عنوانا لمرحلة من تاريخ مغرب لم يكتب بعد، فهو قبلا و بعدا كاتب استثنائي، غير معني بالظهور السريع، يتردد كثيرا في النشر، تختمر الفكرة عنده لسنوات عدة، يتردد في إطلاق سراحها، يعيد صياغتها من جديد، و حين تكتمل القصيدة، تأسر، تزعج، و تنتقل بقارئها إلى شهود لحظوي مائز.
في أنفاسه الفرنسية، نقرأ شعرا معتقا، لا يكل من تفجير الأسئلة، من مقاومة البداهة، من محاكمة “موت الإنسان” و اغتيال المعنى، و كأنه يستعيد نيتشه و هو يقول “لست مسؤولا عن كل هذا الدمار و الساعة ساعة شك”، لكن عاهد يستشعر المسؤولية بهشاشة الشاعر فيه، بيقظة الصحافي فيه، و بألق المثقف العضوي الذي لا يغادره بالمرة. فموجة التفاهة التي أنتجتها ثقافة “نسخ/لصق”، تجعله يصيح عاليا” هل تنقرض مهنة الكاتب فعلا؟و هل الأنترنيت هو رصاصة الرحمة التي يطلقها أطفالنا على الكتاب؟”