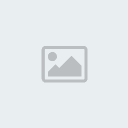1 الجمود الموجع في سوريا الإثنين أبريل 23, 2012 7:23 am
الجمود الموجع في سوريا الإثنين أبريل 23, 2012 7:23 am
admin
Admin

يعطي تسارع وتيرة الأحداث في سوريا الانطباع، بأن نظام الرئيس بشار الأسد
يقترب سريعاً من لحظة الحقيقة. فواقع أن أيام النظام باتت معدودة، لم يَعُد
في موضع شك، لكن كم عددها يظلّ سؤالاً مفتوحاًً: لا يمكنه أن ينتصر، لكنه
يستطيع الصمود وإطالة أمد الصراع.
لقد وصف عدد من التقارير التي
ظهرت في النصف الثاني من يناير القيادة السورية، بأنها غير قادرة على نحو
متزايد على التغلّب على التحدّيات المسلحة، لسيطرتها على البلدات والأحياء،
حتى تلك الواقعة داخل المنطقة الحضرية الكبرى لدمشق. كما يبدو أن الخناق
الدبلوماسي على النظام يشتدّ أكثر، فقد أعقب القرار الجماعي لدول مجلس
التعاون الخليجي بسحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية، على الفور، إطلاق
خطة عربية جديدة دعت الأسد إلى التنحي. ومن ثم علقت الجامعة مهمة بعثتها،
رغم أن السلطات السورية كانت قد وافقت لتوّها على التمديد شهراً آخر، وأخذت
خطتها الجديدة إلى الأمم المتحدة كي يتبناها مجلس الأمن الدولي.
هذه هي
المرة الثانية في غضون شهرين التي يبدو فيها أن الأزمة السورية تتّجه
بسرعة نحو نقطة تحوّل، بسبب القوة الدافعة لتركيبة الأحداث نفسها. ففي
أواخر نوفمبر، أعلنت الجامعة فرض مقاطعة اقتصادية تستهدف السلطات السورية،
وتبعتها مبادرة غربية لفرض عقوبات من جانب الأمم المتحدة، عرقلتها روسيا
والصين. وبعدها كثرت الدعوات المنادية بإقامة منطقة حظر جوي، أو ملاذات
حدودية آمنة محميّة للاجئين، و«ممرّات إنسانية» لإيصال المساعدات إلى
السكان المحاصرين داخل البلاد. وتزايدت التقارير التي تتحدّث عن حصول
انشقاقات في الجيش. ومن جانبه أطلق النظام السوري «بالونات اختبار» تتضمّن
مقترحات سياسية تهدف في الظاهر إلى إبداء استعداده للتوصّل إلى حلّ عن طريق
التفاوض.
ومع ذلك، التغيير الدراماتيكي قد لا يكون وشيكاً. فالنظام لا
يزال يملك ما يكفي من القوة والموارد– الاجتماعية والاقتصادية، والقمعية
على وجه الخصوص– التي تمكّنه من تأخير زواله، ولكن ليس للتغلّب على خصومه.
العامل
الحاسم في المسألة هو أنه، على الرغم من تنامي الضغوط والتوقّعات الدولية،
لن يكون هناك أي تدخّل عسكري خارجي قبل انهيار النظام، لأنه لو حصل،
فسيؤخر حصول انقسامات في داخل القيادة السورية، ويسرّع وتيرة انشقاق مؤيّدي
النظام من أبناء الطبقة الوسطى، مما يفضي إلى ترجيح كفّة التوازن الداخلي
بشكل حاسم. بيد أن الجامعة العربية، التي قامت بأكثر مما قامت به أي جهة
خارجية فاعلة أخرى، وصلت إلى طريق مسدود، لا يرجّح لمجلس الأمن الدولي أن
يجد له مخرجاً.
وفي ظلّ غياب التدخّل العسكري الخارجي، فإن مسار
التطورات داخل سوريا نفسها سيتشكّل عن طريق إرث علاقات الدولة- المجتمع
والاقتصاد السياسي نفسه الذي حدّد أين ستبدأ الانتفاضة وتنتشر، وأين تظل
قائمة إلى الآن: في المحافظات، وبين سكان الريف والفقراء في المناطق
الحضرية. ولعل هذا لا يفسّر الطبيعة المتنوّعة والمنقسمة للمعارضة فقط،
لكنّه ينذر بأن الهياكل القيادية المدنية البارزة للمعارضة قد تجد نفسها
مضطرّة أكثر فأكثر، إلى التنازل عن الدور الرئيسي، في وضع أجندة العمل
لمصلحة الجيش السوري الحر. بيد أن ما يثير القلق أكثر، هو أن ينتقل ذلك
الدور إلى القوى المحلية غير المتجانسة، وربما المنقسمة التي تقود عملية
التحوّل المتزايد، إلى الصراع المسلّح ضد النظام، والتي تحدث في عشرات
المواقع المنتشرة في أنحاء البلاد.
عامل الإرث
تشير طبيعة
العلاقات بين الدولة والمجتمع، وخصوصاً على النحو الذي يشكّلها الاقتصاد
السياسي للبلاد وتنعكس فيه، إلى أن المجموعة نفسها من العوامل التي تمكّن
في الوقت الراهن مختلف الفئات الاجتماعية من التحرّر من سيطرة الحكومة،
تمكّن النظام أيضاً من إطالة أمد وجوده.
وتبدو مقارنة الحالة السورية
بالتجربة العراقية في أعقاب حرب الخليج الأولى 1990-1991 مفيدة في هذا
الصدد، إذ إن نظام صدام حسين ردّ بشراسة على الانتفاضات المسلّحة على
جبهتين (في الشمال والجنوب)، وتمكّن لاحقاً من الصمود أمام العقوبات
والحصار، إلى أن وقع الغزو الأميركي عام 2003.
لم يتعرّض النظام السوري
حتى الآن إلى هذا النوع من الضغط. لكن الأهمّ من ذلك هو أنه يفتقر إلى
القبضة القوية على شعبه التي كانت تتوافّر لنظيره العراقي على مدى عقود،
مما يجعله أكثر عرضة إلى العصيان الجماعي على النطاق الذي نشهده في الوقت
الحاضر. كما أن الاقتصاد السياسي السوري يختلف اختلافا جذرياً، مع وجود
انعكاسات كبيرة على قدرة النظام على مواجهة أو قمع المعارضة واسعة النطاق.
وفي
حين تتضاءل سلطة الحكومة، فإنه يجري استبدالها بخليط من الجماعات المسلحة
والفصائل السياسية، والانتهازيين شبه الجنائيين. لكن ما لم تكن حركات
المعارضة الرئيسة قادرة على جذب معظم هؤلاء إلى ما يشبه الهيكل الموحد
والفاعل تحت قيادتها، سيثبت النظام السوري أنه قادر على إبرام صفقات مع
«الزعماء» المحليين، أو تحريض الفصائل المتنافسة بعضها ضد بعض. فهو يؤكّد
بالفعل على شبح العنف العشوائي والتطرّف الطائفي لردع قطاعات واسعة من
الطبقات الوسطى الحضرية، عن الانتقال إلى المعارضة العلنية، على الرغم من
عدائها للنظام وازدياد أعبائها الاقتصادية.
ما يمنح النظام السوري
قسطاً إضافياً من الحياة، هو الانحسار الشديد للخيارات أمام معارضيه
الإقليميين والدوليين. فالجامعة العربية رفعت سقف مطالبها بشكل كبير، لكن
الحزم الذي أظهرته الجامعة يخفي معضلة، إذ إن اعترافها بأن ليس بوسعها أن
تفعل أكثر مما فعلت، كامن في قراراتها الأخيرة. ومن اللافت للنظر أن
الجامعة لم تُع.دْ فرض المقاطعة الاقتصادية التي رُف.عتْ في وقت لاحق،
عندما وقّعت دمشق المبادرة العربية، كما أنها لم تنفّذ تهديدها السابق بحظر
رحلات الطيران. وهذا يعكس عدم وجود توافق في الآراء بين الدول الأعضاء.
لهذا
السبب اتّجهت الجامعة إلى مجلس الأمن. لكن تصلّب المواقف الروسية والصينية
يوحي بأنه ستتم عرقلة عمل الأمم المتحدة أو تخفيفه. وقد يتفق الجميع في
نهاية المطاف على تشديد العقوبات، ولكن التجارب تشير إلى أن النظام يمكنه
البقاء لبعض الوقت.
لن يكون هناك تدخّل عسكري خارجي، حتى لو عكست روسيا
والصين مواقفهما تماماً. ولن يعاد تكرار السيناريو الليبي، لأسباب مختلفة،
أهمها أن العمل العسكري الخارجي ربما يوحّد عدداً من السوريين خلف النظام،
ويوازي من هم ضدّه، ويمكن للجيش السوري أن يظهر دفاعاً أقوى بكثير من القوة
الليبية قليلة التجهيز ومنخفضة الروح المعنوية.
في المقابل الجيش
السوري الحرّ لا يشكّل حتى الآن تهديداً عسكرياً استراتيجياً، ولا يرجّح له
ذلك في ظل غياب الحماية العسكرية الخارجية.
دخلت سوريا مرحلة «جمود
موجع» قد تستمرّ شهوراً وليس سنوات، ولكن بالتأكيد شهوراً وليس أسابيع. وقد
وصلت الضغوط الخارجية والتحديات الداخلية إلى أقصى مدى يمكن أن تصل إليه
في المستقبل المنظور. النظام غير قادر على قمع الثورة، لكن المعارضة تبدو
هي الأخرى غير قادرة أيضاً على توسيع نطاق أعمالها، أو تأكيد قيادتها
السياسية الواضحة، أو سيطرتها العملياتية الفعّالة على حالة الفوضى
المتزايدة على الأرض. كما أن تحوّل الأزمة إلى تنافس جيو-سياسي بين القوى
الإقليمية والدولية الكبرى يرفع السقف، ويعرقل المسارات البديلة لحلّ
النزاع، ويزيد من مخاطر العنف الطائفي.
سيناريوهان اثنان
هناك
سيناريوهان اثنان لتحول الأزمة. الأول: أن تصل عناصر داخل الطائفة العلوية-
ربما قيادتها الدينية التقليدية، أو بعض القادة العسكريين من خارج الدائرة
المباشرة لعائلة الأسد وعشيرته- إلى استنتاج مفاده أنهم لا يمكن سوى أن
يهزموا في حال نشوب صراع عسكري مطوّل أو حرب أهلية. عندها يمكنهم أن يضغطوا
على الرئيس بهدف إقناعه بالتفاوض ضمن شروط مواتية مادام بوسعه القيام
بذلك.
ولكن في حال عدم حدوث ذلك، أو لو حدث وفشل، فسوف يتآكل النظام من
الداخل تدريجياً إلى أن يصل إلى نقطة تحوّل، وتبدأ سلطته بالانهيار على
مستوى جهاز الدولة برمتّه، مما يطلق شلالاً من الانشقاقات، عندها يدرك
الجيش وموظّفو الوزارات والدوائر وسكان المدن أن النظام لن يصمد أكثر. لا
يمكن التنبّؤ بالضبط بما يمكن أن يتسبب في «انفراط المَسبَحة»، لكنه قد لا
يحدث لبعض الوقت.
القبس

يقترب سريعاً من لحظة الحقيقة. فواقع أن أيام النظام باتت معدودة، لم يَعُد
في موضع شك، لكن كم عددها يظلّ سؤالاً مفتوحاًً: لا يمكنه أن ينتصر، لكنه
يستطيع الصمود وإطالة أمد الصراع.
لقد وصف عدد من التقارير التي
ظهرت في النصف الثاني من يناير القيادة السورية، بأنها غير قادرة على نحو
متزايد على التغلّب على التحدّيات المسلحة، لسيطرتها على البلدات والأحياء،
حتى تلك الواقعة داخل المنطقة الحضرية الكبرى لدمشق. كما يبدو أن الخناق
الدبلوماسي على النظام يشتدّ أكثر، فقد أعقب القرار الجماعي لدول مجلس
التعاون الخليجي بسحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية، على الفور، إطلاق
خطة عربية جديدة دعت الأسد إلى التنحي. ومن ثم علقت الجامعة مهمة بعثتها،
رغم أن السلطات السورية كانت قد وافقت لتوّها على التمديد شهراً آخر، وأخذت
خطتها الجديدة إلى الأمم المتحدة كي يتبناها مجلس الأمن الدولي.
هذه هي
المرة الثانية في غضون شهرين التي يبدو فيها أن الأزمة السورية تتّجه
بسرعة نحو نقطة تحوّل، بسبب القوة الدافعة لتركيبة الأحداث نفسها. ففي
أواخر نوفمبر، أعلنت الجامعة فرض مقاطعة اقتصادية تستهدف السلطات السورية،
وتبعتها مبادرة غربية لفرض عقوبات من جانب الأمم المتحدة، عرقلتها روسيا
والصين. وبعدها كثرت الدعوات المنادية بإقامة منطقة حظر جوي، أو ملاذات
حدودية آمنة محميّة للاجئين، و«ممرّات إنسانية» لإيصال المساعدات إلى
السكان المحاصرين داخل البلاد. وتزايدت التقارير التي تتحدّث عن حصول
انشقاقات في الجيش. ومن جانبه أطلق النظام السوري «بالونات اختبار» تتضمّن
مقترحات سياسية تهدف في الظاهر إلى إبداء استعداده للتوصّل إلى حلّ عن طريق
التفاوض.
ومع ذلك، التغيير الدراماتيكي قد لا يكون وشيكاً. فالنظام لا
يزال يملك ما يكفي من القوة والموارد– الاجتماعية والاقتصادية، والقمعية
على وجه الخصوص– التي تمكّنه من تأخير زواله، ولكن ليس للتغلّب على خصومه.
العامل
الحاسم في المسألة هو أنه، على الرغم من تنامي الضغوط والتوقّعات الدولية،
لن يكون هناك أي تدخّل عسكري خارجي قبل انهيار النظام، لأنه لو حصل،
فسيؤخر حصول انقسامات في داخل القيادة السورية، ويسرّع وتيرة انشقاق مؤيّدي
النظام من أبناء الطبقة الوسطى، مما يفضي إلى ترجيح كفّة التوازن الداخلي
بشكل حاسم. بيد أن الجامعة العربية، التي قامت بأكثر مما قامت به أي جهة
خارجية فاعلة أخرى، وصلت إلى طريق مسدود، لا يرجّح لمجلس الأمن الدولي أن
يجد له مخرجاً.
وفي ظلّ غياب التدخّل العسكري الخارجي، فإن مسار
التطورات داخل سوريا نفسها سيتشكّل عن طريق إرث علاقات الدولة- المجتمع
والاقتصاد السياسي نفسه الذي حدّد أين ستبدأ الانتفاضة وتنتشر، وأين تظل
قائمة إلى الآن: في المحافظات، وبين سكان الريف والفقراء في المناطق
الحضرية. ولعل هذا لا يفسّر الطبيعة المتنوّعة والمنقسمة للمعارضة فقط،
لكنّه ينذر بأن الهياكل القيادية المدنية البارزة للمعارضة قد تجد نفسها
مضطرّة أكثر فأكثر، إلى التنازل عن الدور الرئيسي، في وضع أجندة العمل
لمصلحة الجيش السوري الحر. بيد أن ما يثير القلق أكثر، هو أن ينتقل ذلك
الدور إلى القوى المحلية غير المتجانسة، وربما المنقسمة التي تقود عملية
التحوّل المتزايد، إلى الصراع المسلّح ضد النظام، والتي تحدث في عشرات
المواقع المنتشرة في أنحاء البلاد.
عامل الإرث
تشير طبيعة
العلاقات بين الدولة والمجتمع، وخصوصاً على النحو الذي يشكّلها الاقتصاد
السياسي للبلاد وتنعكس فيه، إلى أن المجموعة نفسها من العوامل التي تمكّن
في الوقت الراهن مختلف الفئات الاجتماعية من التحرّر من سيطرة الحكومة،
تمكّن النظام أيضاً من إطالة أمد وجوده.
وتبدو مقارنة الحالة السورية
بالتجربة العراقية في أعقاب حرب الخليج الأولى 1990-1991 مفيدة في هذا
الصدد، إذ إن نظام صدام حسين ردّ بشراسة على الانتفاضات المسلّحة على
جبهتين (في الشمال والجنوب)، وتمكّن لاحقاً من الصمود أمام العقوبات
والحصار، إلى أن وقع الغزو الأميركي عام 2003.
لم يتعرّض النظام السوري
حتى الآن إلى هذا النوع من الضغط. لكن الأهمّ من ذلك هو أنه يفتقر إلى
القبضة القوية على شعبه التي كانت تتوافّر لنظيره العراقي على مدى عقود،
مما يجعله أكثر عرضة إلى العصيان الجماعي على النطاق الذي نشهده في الوقت
الحاضر. كما أن الاقتصاد السياسي السوري يختلف اختلافا جذرياً، مع وجود
انعكاسات كبيرة على قدرة النظام على مواجهة أو قمع المعارضة واسعة النطاق.
وفي
حين تتضاءل سلطة الحكومة، فإنه يجري استبدالها بخليط من الجماعات المسلحة
والفصائل السياسية، والانتهازيين شبه الجنائيين. لكن ما لم تكن حركات
المعارضة الرئيسة قادرة على جذب معظم هؤلاء إلى ما يشبه الهيكل الموحد
والفاعل تحت قيادتها، سيثبت النظام السوري أنه قادر على إبرام صفقات مع
«الزعماء» المحليين، أو تحريض الفصائل المتنافسة بعضها ضد بعض. فهو يؤكّد
بالفعل على شبح العنف العشوائي والتطرّف الطائفي لردع قطاعات واسعة من
الطبقات الوسطى الحضرية، عن الانتقال إلى المعارضة العلنية، على الرغم من
عدائها للنظام وازدياد أعبائها الاقتصادية.
ما يمنح النظام السوري
قسطاً إضافياً من الحياة، هو الانحسار الشديد للخيارات أمام معارضيه
الإقليميين والدوليين. فالجامعة العربية رفعت سقف مطالبها بشكل كبير، لكن
الحزم الذي أظهرته الجامعة يخفي معضلة، إذ إن اعترافها بأن ليس بوسعها أن
تفعل أكثر مما فعلت، كامن في قراراتها الأخيرة. ومن اللافت للنظر أن
الجامعة لم تُع.دْ فرض المقاطعة الاقتصادية التي رُف.عتْ في وقت لاحق،
عندما وقّعت دمشق المبادرة العربية، كما أنها لم تنفّذ تهديدها السابق بحظر
رحلات الطيران. وهذا يعكس عدم وجود توافق في الآراء بين الدول الأعضاء.
لهذا
السبب اتّجهت الجامعة إلى مجلس الأمن. لكن تصلّب المواقف الروسية والصينية
يوحي بأنه ستتم عرقلة عمل الأمم المتحدة أو تخفيفه. وقد يتفق الجميع في
نهاية المطاف على تشديد العقوبات، ولكن التجارب تشير إلى أن النظام يمكنه
البقاء لبعض الوقت.
لن يكون هناك تدخّل عسكري خارجي، حتى لو عكست روسيا
والصين مواقفهما تماماً. ولن يعاد تكرار السيناريو الليبي، لأسباب مختلفة،
أهمها أن العمل العسكري الخارجي ربما يوحّد عدداً من السوريين خلف النظام،
ويوازي من هم ضدّه، ويمكن للجيش السوري أن يظهر دفاعاً أقوى بكثير من القوة
الليبية قليلة التجهيز ومنخفضة الروح المعنوية.
في المقابل الجيش
السوري الحرّ لا يشكّل حتى الآن تهديداً عسكرياً استراتيجياً، ولا يرجّح له
ذلك في ظل غياب الحماية العسكرية الخارجية.
دخلت سوريا مرحلة «جمود
موجع» قد تستمرّ شهوراً وليس سنوات، ولكن بالتأكيد شهوراً وليس أسابيع. وقد
وصلت الضغوط الخارجية والتحديات الداخلية إلى أقصى مدى يمكن أن تصل إليه
في المستقبل المنظور. النظام غير قادر على قمع الثورة، لكن المعارضة تبدو
هي الأخرى غير قادرة أيضاً على توسيع نطاق أعمالها، أو تأكيد قيادتها
السياسية الواضحة، أو سيطرتها العملياتية الفعّالة على حالة الفوضى
المتزايدة على الأرض. كما أن تحوّل الأزمة إلى تنافس جيو-سياسي بين القوى
الإقليمية والدولية الكبرى يرفع السقف، ويعرقل المسارات البديلة لحلّ
النزاع، ويزيد من مخاطر العنف الطائفي.
سيناريوهان اثنان
هناك
سيناريوهان اثنان لتحول الأزمة. الأول: أن تصل عناصر داخل الطائفة العلوية-
ربما قيادتها الدينية التقليدية، أو بعض القادة العسكريين من خارج الدائرة
المباشرة لعائلة الأسد وعشيرته- إلى استنتاج مفاده أنهم لا يمكن سوى أن
يهزموا في حال نشوب صراع عسكري مطوّل أو حرب أهلية. عندها يمكنهم أن يضغطوا
على الرئيس بهدف إقناعه بالتفاوض ضمن شروط مواتية مادام بوسعه القيام
بذلك.
ولكن في حال عدم حدوث ذلك، أو لو حدث وفشل، فسوف يتآكل النظام من
الداخل تدريجياً إلى أن يصل إلى نقطة تحوّل، وتبدأ سلطته بالانهيار على
مستوى جهاز الدولة برمتّه، مما يطلق شلالاً من الانشقاقات، عندها يدرك
الجيش وموظّفو الوزارات والدوائر وسكان المدن أن النظام لن يصمد أكثر. لا
يمكن التنبّؤ بالضبط بما يمكن أن يتسبب في «انفراط المَسبَحة»، لكنه قد لا
يحدث لبعض الوقت.
القبس