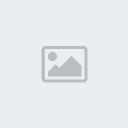1 الثقافة المغربية : أصولها وخصوصياتها الأربعاء فبراير 03, 2010 4:26 am
الثقافة المغربية : أصولها وخصوصياتها الأربعاء فبراير 03, 2010 4:26 am
حواء
مشرف عام
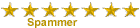
الثقافة المغربية : أصولها وخصوصياتها
إن لكل بلد ما يميزه في المجال المادي، كالعمارة وما إليها من منشآت غالبا ما تدخل في نطاق الحضارة، كما أن له في الميدان الأدبي ما يطبعه من خصائص تبرزها المفاهيم والأفكار والقيم وما يرتبط بها من مبدعات وأنماط سلوكية وممارسات واعية أو عفوية، وما تعكسه من عادات وتقاليد وما إليها من نظم اجتماعية وغيرها،هي التي اعتاد الناس أن يطلقوا الثقافة؛وإن كنا لا نرى ما يبرر هذا التفريق، لما بين الحضارة والثقافة من تداخل وتكامل.
ومن ثم يمكن القول بأن الثقافة وهي ظاهرة طبيعية، تتضمن مجموع العناصر الإنسانية التي تشكل فكر الإنسان وسلوكه وتضبط علاقاته مع غيره، أي مع الكون والحياة والناس.وهي عناصر تكتسب بالتعلم والممارسة، إلى جانب ما يتوارث بالفطرة والغريزة، في تمايز بين المجتمعات، وقابلية وللتواصل والاحتكاك،وتبادل التأثر والتأثير، وقدرة على صنع هذه العناصر وإخضاعها تلقائيا للحاجات بالتكييف والتطوير والتغيير.
إن الثقافة بهذا نشاط إنساني وفعالية تحرك الوجود، في تفاعل يفضي إلى التنوع والتعدد، وإلى التباين والاختلاف، وفق معطيات مختلفة بيئية وفكرية ونفسية، وحتى جسمية،هي التي تتيح إنشاء ثقافة بخصوصيات معينة، قد تلتقي مع غيرها في تكامل يتحقق معه التماثل والوحدة، ومعهما تتسنى للأفراد والمجتمعات حياة ذاتية خاصة، وحياة عامة مشتركة من خلالها يكون التواصل والتعارف في نطاق ما يجمع من مصالح لازمة ومنافع ضرورية.
وعلى الرغم من أن مظاهر هذا النشاط ـ سواء في بعدها المادي أو الأدبي ـتتعرض عبر الأزمنة المتعاقبة لقليل أو كثير من التطوير وربما التغيير، فإنها تظل محتفظة بملامح ثابتة قد تتفرد بها دالة على طبيعة الإنسان الذي يتسم بها أو تتسم بها حياته، مما قد يؤدي في البحث الأنتروبولوجي بصفة خاصة إلى استنتاجات تصل إلى حد تحديد انتماء هذا الإنسان إلى جنس معين أو سلالة محددة.
بمثل هذه الأبعاد التي تكون للثقافة وغيرها يمكن استخلاص ملامح الشخصية في جوانبها المختلفة، والمقصود بها الملامح الثابتة وإن ثبوتا نسبيا بالقياس إلى السمات المتغيرة. وانطلاقا من تلك الملامح يمكن التمييز بين وشخصية وأخرى، أي بين مجتمع وآخر، وربما فرد وآخر؛ دون إغفال المقومات التي غالبا ما تطبع المنتمين إلى مجتمع بعينه، والتي تجعل منهم أصحاب تفكير تركيبي أو ذهنية ذاتية، وكذا أصحاب سلوك قد يتسم بالهدوء والاعتدال أ, الحدة والتطرف
ذلكم أن أي مجتمع يشكل لنفسه ثقافة تستجيب لحاجاته الفكرية والنفسية والاجتماعية . وبقدر ما تكون هذه الاستجابة تكون قوة الثقافة.وبقدر ما تكون مضامين هذه الثقافة متكاملة وهادفة لغايات، يكون اتجاه الثقافة في خط علمي عملي، أو في خط وهمي خرافي، وإن كانا معا يسعيان إلى تنظيم المعارف والعلاقات وأنماط الحياة المختلفة، وربطها جميعا بالمعتقدات التي يقع الاطمئنان إليها عند تفسير الخوارق التي تستعصي على إدراك البشر
وإن دراسة ثقافة ما لتقتضي التوسل بمناهج متعددة، تاريخية وإتنولوجية ولغوية ونفسية وأنتروبولوجيية،وخاصة منهج الأنتروبولوجيا الثقافية التي تدرس الظاهرة الثقافية من حيث مكوناتها وخصائصها وعلاقاتها بغيرها، وما عرفته من تطور خلال الأزمان، وفق معايير ومقاييس إذا ما حللت الثقافة في ضوئها أمكن التحفز من الماضي لاستشراف المستقبل.
وليس من شك في أن الثقافة في عمومها، ومن خلال تتبع شتى ظواهرها في بلد معين، تكشف مدى ملاءمة ما لهذا البلد من معطيات بيئية،مع ما يعتمل فيه من عناصر تاريخية،وكذا مع المقومات البشرية لساكنيه،وحاجتهم إلى التواصل وأدوات لهذا التواصل.
وقد يتجمع ذلك كله في الواقع الذي تصبح الثقافة اختزالا له ولعلاقة الإنسان به، عبر أشكال تعبيرية مختلفة مكتوبة وشفوية، ومن خلال تلك الأدوات وفي طليعتها اثنتان:
ـ اللغة،ليس فقط باعتبارها ألفاظا لها دلالات،ولكن باعتبارها رموزا تخفي مفاهيم ورؤى يختلف الكشف عنها من مجتمع لآخر، وربما من فرد لآخر، حسب القدرة على التفكير والإعراب عنه.
ـ المعتقد الذي هو في الحقيقة يشكل روح تلك الثقافة وجوهرها،والكل المتحكم في الأجزاء، مهما تكن هذه الأجزاء متنوعة ومتعددة وغنية خصيبة، ومهما تكن الشبكة التي تشكلها دقيقة ومتفرعة.
وإذا كانت هذه "الشبكة الثقافية" تبدو ملتئمة الخيوط ملتحمة النسيج، بعد فترات تفاعل ومراحل مخاض، عن طريق احتكاك قد يبلغ حد الصراع، فإن مرد ذلك إلى تمحورها حول نواة هي التي يمكن أن نعتبرها أصلا أو أصولا لتلك الثقافة؛ داخلها وانطلاقا منها يحدث التأقلم ويتحقق التوحد، أي يتشكل الكيان الذي يضم ما قد تمثله الثقافة في حال تنوع روافدها وتعدد فروعها، ومعه تتشكل ذات الجماعة وشخصية الأمة بعيدا عن أي مظهر للتشتت والانفصام أو التمزق والانقسام
وإضافة إلى ما يكون لهذه الأصول من رسوخ عميق في النفوس، وفي شتى محتويات الثقافة وأشكالها، فإنها تكون باستمرار حافزة إلى استحضارها وإحيائها والاستمداد منها، لا سيما عند الشعور بمضامين وأشكال ثقافية بعيدة عن تلك الأصول، تزعج وتهدد بتسرباتها البطيئة الخفية أو السريعة المكشوف
على أن الحديث عن الأصول لا يعني فقط الوصول إلى الجذور الأولية أو البدائية التي لا تنجلي بعض آثارها إلا بالحفر والتخمين، على أهمية هذه الجذور وإبراز ما لها من أثر، بقدر ما يعني كذلك الوقوف على الثوابت التي عبرتها مختلف موجات الحياة، وتعاقبت عليها شتى دورات النمو، فلم تزدها إلا غنى وقوة كانت بهما قادرة على امتصاص ما يوافقها وينسجم معها، وكذا على نفي ما يشوبها أو يتناقض معها؛ شأنها في ذلك شأن الجسم يرفض ما هو غريب عنه ودخيل، طالما أنه ينعم بالصحة والحيوية والمناعة، ويتمتع بإمكانات الصمود والاستمرار ولعل في قدرة هذه الثوابت على اكتساب الجديد الملائم لها ما يجعلها على الدوام تسير في خط الرقي والتقدم، غير ساكنة جامدة ولا منتكسة متخلفة.
وحين نوجه نظرنا نحو المغرب، فإننا لا نرى إمكان الحديث عنه في جميع شؤونه ومتعلقاته، ثقافية كانت أو غيرها، من غير أن نستحضر عنصرين اثنين: موقعه وسكانه
ـ أما الموقع فمحصور في أقصى شمال القارة الإفريقية، مطلا على بحرين عظيمين،أحدهما وهو الأطلسي لم يكن خلال التاريخ القديم سوى فضاء مظلم، والآخر وهو الأبيض المتوسط كان على الدوام معبرا بين الشرق والغرب ومجال حركة حضارية وثقافية مستمرة. والمغرب بانتمائه الإفريقي يبدو ممدود النظر واليد باستمرار للشرق من جهة، ولما بعد الصحراء من جهة أخرى؛ في حين يواجه في شماله قارة أروبية كان له مع بعض دولها كثير من الاحتكاك والصدام، في مد وجزر لم يعرف الانقطاع قط.
والمغرب بحكم هذا الموقع المحتوم وما يفرضه عليه، كان على امتداد الحقب يعاني تأرجحا إن لم نقل اضطرابا وحيرة بين الانفتاح على التيارات التي تهب عليه رياحها، وبين الانغلاق حماية لنفسه من الزوابع التي قد تصاحب هذه الرياح،مما جعله في نهاية الأمر يشعر بشيء من الانعزال عن المراكز التي كانت تظهر فيها الديانات،وتعتمل فيها الحضارات والثقافات، لا سيما الشرق
ـ وأما السكان، فلا نرى حاجة إلى أن نثبت أنهم من البربر الأمازيغ ومن العرب، بحكم اندماجهم داخل بوتقة الإسلام باعتباره رسالة إنسانية عالمية، وبدءا من عصره الأول، يكونون نسيجا مغربيا متلاحما ذابت فيه كل الفوارق وزالت به جميع العناصر الجزئية، إلا ما كان من بعض الخصوصيات الثقافية التي استطاع التشكيل الاجتماعي أن يهضمها ويدمجها أو يحتفظ بها ويغتني، كبعض العادات والممارسات وأنماط الفنون والآداب المنبعثة من إبداع اللهجات المحلية؛ دون أن ننسى أن أولئك البربر هم عرب في الأصل، إذ ليس يخفى أن المؤرخين ودارسي الأجناس والسلالات أثبتوا للعرب أصولا في إفريقيا الشمالية التي منها اتجهوا منذ العصرين الحجري القديم والحديث، أي قبل الميلاد بأزيد من عشرة آلاف عام،إلى شبه الجزيرة العربية، حيث استقروا بجنوبها في أول الأمر، مارين بمعبر السويس في مصر.كما أثبتوا الشبه بينهم وبين البربر، لا سيما فيما يتعلق بالملامح الخلقية الجنسية، وحتى اللغوية والفنية، إضافة إلى بعض العادات وما إليها من مظاهر اجتماعية. في حين يرى غير هؤلاء من علماء الحفريات، أن العرب هم الذين نزحوا منذ هذين العصرين إلى الشمال الإفريقي وافدين من شبه الجزيرة العربية، وأنهم اختلطوا عند وصولهم بشعوب أخرى كانت قادمة من أروبا عبر شبه الجزيرة الإيبيرية.
مهما يكن فإن أصل السكان المغاربة كامن في العروبة الحميرية التي تربطهم بشبه الجزيرة العربية، وكامن كذلك فيما يثبته الواقع التاريخي من اختلاط تواصل بفعل الهجرات العربية المشرقية المتعددة التي اتجهت نحو المغرب خلال العصور الإسلامية، لا سيما طوال القرون السبعة الأولى، ثم الهجرات الأندلسية التي عرفت أوجها على إثر انتهاء وجود الدولة الإسلامية في شبه الجزيرة الإيبيرية، تكون نسيج تشكلت به وحدة وطنية ودينية عاش المغاربة في ظلها مجتمعين، يتملكهم شعور بهذه الوحدة، هو الذي كان دائما يحثهم على التمسك بالأرض والدفاع عنها ورد كل محاولة للاعتداء عليها.
وفي بوتقة هذه الوحدة، تبلورت ملامح ثقافة مغربية كانت مسبوقة لا شك بشتى مظاهر الحياة البشرية التي عرفها المغرب في مراحل ما قبل التاريخ، على نحو ما أبرزته الاكتشافات الأثرية من عظام وأدوات وحلي ونقوش وكتابات تذكر في مضمونها بما كان عند قدماء المصريين من معتقدات،وتحيل في شكلها إلى لهجتهم التي تنتسب مثلها إلى المجموعة الكوشية أو الحامية، في قرابة مع الأصل السامي، وفي توسل بحروف التيفيناغ التي هي ذات مرجعية ليبية
وقد أتيح لهذه الثقافة أن تكتسب بعض الجديد في العهد الفينيقي الذي بدأ منذ منتصف القرن الثاني عشر قبل الميلاد، والذي استمر الاحتكاك به نحوا من ألف عام. وهو احتكاك قوى هذه الثقافة في سياق التوجه الشرقي الذي كانت تمتزج فيه مظاهر مصرية وأخرى إغريقية
وعلى الرغم من أن المغرب بعد الحروب البونيقية التي دارت بين القرطاجنيين والرومان، والتي دامت من منتصف القرن الثاني قبل الميلاد إلى منتصف الخامس بعده، تعرض للغزو الروماني، فإنه ظل محتفظا بطابع ثقافته التي حاول الغزاة أن يستبدلوا بها ثقافتهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك إلا في نطاق ضيق كانت تمثله فئة من المتعلمين والموظفين وأصحاب المصالح، هم الذين استعملوا اللغة اللاتينية واعتنقوا المسيحية.
ومع أن المغاربة ميالون إلى التوحيد، فإنهم لم يقبلوا على هذا الدين، لارتباطه بالاستعمار الروماني،إلا ما كان من تلك الفئة التي لم تلبث أن دخلت الإسلام، مما لم يبق معه للمسيحية أي أثر في المغرب. كما أنهم رفضوا اليهودية لارتباطها بالميز العنصري، وإن اعتنقتها مجموعة محدودة، أسلم معظمها، من غير أن يقضى على الدين اليهودي الذي استمر عند قلة من المغاربة لا تذكر، مما أتاح له أن يستمر عند هذه القلة، وكذا عند بعض اليهود الذين هاجروا إلى المغرب بعد أن طردوا من الأندلس ولم يسلموا، وحافظوا في نطاق دولته ـ باعتبارهم من الكتابيين أهل الذمة ـ على عقيدتهم وثقافتهم التي كانت في انعزالها ذات صيغة دينية، ولم يتسن لها أن تحتك بعموم الثقافة المغربية إلا من خلال بعض المهارات الصناعية وبعض الفنون، على نحو ما كان لهم من اعتناء في العصور المتأخرة بطرب الملحون وموسيقى الآلة التي كان لليهود فيها تبريز متميز.
ومن ثم، فإن المغاربة واجهوا كل تلك التحديات،وظلوا محافظين على ثقافتهم، وعبرها أثبتوا وجودهم الذي تمثل في بعض الإمارات المستقلة،والذي بقي صامدا في وجه الغزاة الوندال الذين جاءوا من جرمانيا، والذين استمر احتلالهم من منتصف القرن الخامس إلى منتصف السادس، وكانوا أهل تخريب وتدمير، في استبداد واستغلال للخيرات، مما جعل تأثيرهم الثقافي لا يذكر.وقد تعرض المغرب بعدهم للغزو البيزنطي الذي واجهه المغاربة بشدة، دون أن يفيدوا منه أي شيء
وهو وضع زاد في تعقيده غموض هذه الفترات التي اتسمت بشيء غير قليل من الاضطراب، والتي مهدت لاعتناق الإسلام وهو الدين الذي سيطبع مسيرة المغرب الثقافية بعد أن طبعها سياسيا وفكريا ولغويا.
وقد مر هذا الاعتناق قبل اكتماله بمراحل بدأت في منتصف القرن الهجري الأول، واستمرت نحو عقدين في القرن الثاني. وهي مراحل طالت بالقياس إلى ما عرفته الفتوحات في أقطار أخرى، لأسباب، من أهمها الموقف الذي للمغاربة في المنطلق من كل وافد يخشون اعتداءه واحتلاله ومسه لحريتهم واستقلالهم.وهو موقف زال بعد اطمئنانهم للدين الجديد، وارتياحهم لمبادئه وقيمه وانسجامهم مع الفاتحين.بل زادوا فكانوا في مقدمة حاملي دعوته إلى الأندلس والمجاهدين لتبليغها ونشرها في كل موقع، والدفاع عنها ورد خصومها بتحد وشجاعة قل لهما نظير
ولا يمكن الحديث عن التحام المغاربة بالإسلام، من غير أن يشار إلى ما كان لهم من اختيار مذهبي قوى هذا الالتحام.
وقد تم هذا الاختيار بعد اختبار لمختلف المذاهب التي عرفها المسلمون، سواء على مستوى السياسة أو العقيدة أو الفقه، بدءا من المذهب الخارجي الذي مال إليه المغاربة أول الأمر، إذ وجدوه يوافق طبيعتهم الاستقلالية ورفضهم لأي ميز عنصري، مما جعلهم يرحبون بأفواج من الخوارج ويتيحون لهم أن يستقروا في المغرب بعد أن هزموا في المشرق.فكان أن تقوى هذا المذهب في الاتجاه الصفري ، وظهر له زعماء مغاربة كميسرة المدغري. كما تكونت له إمارة هي إمارة بني مدرار في سجلماسة.
وقد كاد المغاربة أن يستقروا على الخارجية،لولا تعاطفهم مع آل البيت وانتصارهم لقضيتهم وما كانوا يعانونه من محن في المشرق. وهو ما تمثل في استقبالهم للمولى إدريس، ومبايعته بالإمارة في وليلي عام اثنتين وسبعين ومائة للهجرة، بعد أن تنازل له عنها عبد الحميد بن إسحاق الأوربي الذي حث القبائل على هذه المبايعة.
كذلك كان للاعتزال أثر واضح من خلال جماعة الواصلية التي كانت قبيلة أوربة على رأيها، في حين كان التوجه الفقهي قائما أول الأمر على أساس السنية، ثم وقع الأخذ بمذهب أبي حنيفة الذي هو مذهب أهل الكوفة، مع بعض التأثر بمذهب الأوزاعي الذي عرفته الأندلس بسبب أموية الدولة فيها، وهو مذهب أهل الشام. ولم يلبث المغاربة بعد هذا أن مالوا إلى مذهب مالك الذي هو مذهب أهل المدينة.
ونظرا لأن المغاربة في تجاوبهم مع الأحداث المشرقية كانوا يميزون بين المساندة السياسية والالتزام الفكري، فإنهم حتى وهم يمكنون للمولى إدريس الذي كان يتوقع نشر التشيع في عهده، ظلوا على سنيتهم المالكية، بل جعلوه يدرك هذه الحقيقة ويسير في خط هذه السنية
وعلى الرغم من الاضطراب السياسي والفكري الذي عاشه المغرب بعد انهيار مبكر للدولة الإدريسية،والذي انعكست سلبياته على الثقافة، فإن المذهب ظل مستمرا بحكم عوامل كثيرة، أهمها تمسك المغاربة به لانتمائه إلى عالم المدينة، وكذا رحلاتهم إلى الحجاز لأداء فريضة الحج، إضافة إلى موافقة مزاجهم وعقليتهم.
وقد تقوى هذا الاستمرار بسبب المساندة الرسمية له على امتداد الدول.وهي مساندة عرفت أوجها في عهد المرابطين الذين أنشأوا دولتهم في منتصف القرن الخامس الهجري على أساس من الإصلاح الديني قائم على الفقه المالكي، الذي كان يومئذ وحده القادر على جمع كلمة المغاربة،وتوحيدهم في خط فكري يستند إلى تثبيت قواعد الدين ومبادئه الأولية على نحو بسيط وواضح،ليس فقط على مستوى الفقه، ولكن كذلك على مستوى العقيدة التي أخذ المغاربة فيها بالاتجاه الأشعري الذي كان وسطا بين تيار المتكلمين القائلين بإعمال العقل والتأويل، وتيار السلف الذي كان له موقف من ذلك قائم على الإقرار بالمتشابهات.
وإذا كان المجال لا يتسع لاستيعاب كل ما يكمن خلف سنية المغاربة ومالكيتهم، فإنه لا بد من الإشارة إلى الاستثناء الذي عاشوه مع الموحدين الذين أقاموا دولتهم طوال القرن السادس الهجري على المذهب الذي ابتدعه المهدي بن تومرت، مازجا فيه بين مذاهب شتى، هي الشيعية الإمامية والاعتزال والظاهرية والأشعرية،والذي كان يسعى من ورائه إلى تحقيق هدف سياسي هو تقيض دولة المرابطين الفقهية
إلا أن المغاربة لم يلبثوا أن عادوا إلى ما هم مقتنعون به، في الاتجاه السني المالكي الذي حافظوا به على كيانهم الفكري داخل وحدة الدين
وإذا كانت هذه الوحدة قائمة على الإسلام، فليس فقط باعتباره عقيدة، ولكن باعتباره كذلك نظاما متكاملا تشكل عند المغاربة في النظرية والتطبيق من خلال النموذج السني الذي هو أقرب إلى الصورة النبوية المثلى، وكذا باعتباره فكرا يتوسل بلغة القرآن. ومن ثم استطاع الإسلام أن يحتوي ما كان شائعا من شتى مظاهر العصبية والقبلية ومختلف عوامل التشتيت والتفريق.
وإدراكا لذلك، وربطا للوطنية والسيادة بالإطار الإسلامي، كان التمسك بالإسلام وبالإمامة الشرعية التي جعلت المغاربة منذ تمكينهم للمولى إدريس، يضعون الإمام فوق جميع الاعتبارات
لقد كان لتمسك المغاربة بالحكم الشرعي لسلطة الإمام أثر كبير في توجيه مسيرهم الثقافي، ويبدأ هذا الحكم باعتبار العلم أساسا في اختيار الإمام، إلى جانب شروط أخرى هي الكفاية والعدالة والقرشية وسلامة الحواس.
وقد بلغت العناية بشرط العلم مكانة وصل بها بعض الملوك المغاربة إلى درجة الاجتهاد والتجديد، في حين وقع مس بعضهم ممن لم يتوافر فيهم هذا الشرط على النحو المطلوب، كيوسف بن تاشفين الذي كانت لخصومه وخصوم المغرب دوافع عمقت نظرهم إلى هذه المسألة.
إذا نحن في ضوء هذه المعطيات الأساسية وغيرها مما تسعف به حقائق التاريخ الذي التأم عبره نسيج الوحدة الوطنية، حاولنا أن نتأمل الثقافة المغربية في أهم العناصر التي يمكن اعتبارها دعائم أصلية لها، فإننا سنقف على المكونات والملامح الآتية:
أولا : المكونات، ويمكن حصرها أساسا في ثلاثة :
1ـ الموروث البربري الذي تداوله المغاربة قرونا قبل دخول الإسلام، والذي ما زال ينبض في القلوب ويتدفق فيها بحيوية.
2ـ الرصيد العربي الإسلامي بمقوماته الشرقية والأندلسية والإفريقية.وهو ر صيد أمد هذا الموروث، وأغناه وقواه، ووسع مجالاته، وأكسبه سمات متجددة، وفتح له آفاقا رحبة وصلته مع ثقافة الأمة العربية الإسلامية بأواصر متينة غدا بها وبمساهمته في تمتينها أحد أركان هذه الثقافة، وملمحا متميزا فيها، بقابلية نادرة للأخذ والعطاء.
3 ـ التيارات الوافدة التي أتاحها الموقع الجغرافي والواقع المتطور الناتج عنه، ويغلب عليها الجانب الأروبي، والفرنسي والإسباني منه على الخصوص بحكم علاقات مختلفة تاريخية في مجملها، فرضت ألوانا من الاحتكاك في مد وجزر كانت لهما ردود فعل مختلفة، كما أتاحت كثيرا من مظاهر التأثر لا تخلو من إيجابيات، تسنى بها شيء من التفتح على العالم وبعض التحديث كذلك، وإن كانت لا تخلو أيضا من سلبيات تتضمن عناصر مدسوسة وملغومة.
وإذا نحن استثنينا هذا المكون الثالث الأجنبي، فإننا سنجد أن المكونين الأول والثاني شكلا على امتداد أربعة عشر قرنا ثقافة مغربية توسلت بلغة القرآن، أداة لها تكتسب بها العلوم والآداب والفنون، وتبدع بها في مختلف هذه المجالات، مما لا حاجة إلى التوسع في إبرازه. وقد ساهم المثقفون المغاربة في إغنائه، بغض النظر عن انتماآتهم الإقليمية أو لهجاتهم المحلية، عربية وبربرية، مع الإشارة إلى أنه وقع التوسل بالبربرية مكتوبة بالحرف العربي في تحرير بعض المسائل الفقهية، لتقريبها إلى بعض الناطقين بها من الذين لا يحسنون استعمال العربية، على نحو ما تكشف بعض المدونات؛ ومع الإشارة كذلك إلى أن المهدي بن تومرت، بدافع تحقيق أهدافه السياسية، لجأ إلى البربرية وسيلة للاتصال بالجماهير والتأثير عليها، فدرس بها وألف بها كتبه في المذهب، وزاد فأمر باستعمالها في الشؤون الدينية، كالخطابة والنداء للصلاة.
وتتضمن الثقافة المغربية إلى جانب هذا المجال المدرسي، مجالا آخر هو المتمثل في الإبداع الشعبي الذي هو التعبير عن نفسية الشعب ومفتاح شخصيته، وهو ثمرة إنتاج أفراده وجماعاته على الأجيال وفي شتى الميادين. به أثبت وجوده وقدرته على تأكيد الذات وممارسة جميع متطلبات هذه الذات. ويمثل إحدى النوافذ المهمة التي منها يمكن الإطلال على الثقافة المغربية وأصول هذه الثقافة، لاتخاذها قاعدة لثقافة وطنية ؛ إضافة إلى أنه خير وسيلة لإشراك الشعب في تأسيس هذه الثقافة، وإلى أنه يتضمن طاقات للاستلهام والاستيحاء والتطوير. ويتجلى في العادات والتقاليد باعتبارها مظاهر سلوكية تداخل حياة الناس والمجتمع، وتتحكم في العلاقات، وفي التعامل مع ظواهر الكون والحياة وتفسيرها، انطلاقا من طقوس ومعتقدات مترسبة، وبدون وعي في الغالب. وهي التي توجه الإنسان في شتى أطواره ومجالات حركته ونشاطه وتصرفاته. كما يتجلى في الفنون التي تتوسل بالحركة والإشارة والإيقاع ، كالموسيقى والرقص والألعاب، وبالعمل اليدوي الدقيق، على غرار الرقم والرسم والتزويق والزخرفة، وما إليها جميعا من أنماط رافقت الإنسان منذ مراحل حياته الأولى. بها حكى قصة وجوده،وعبر عن مختلف تلك المراحل، وبها عبر كذلك عن أفراحه وأحزانه وقيمه وشتى مواقفه. ثم هو يتجلى في الأدب الذي يشمل جميع الأنماط الفنية التي تتوسل بالكلمة في التعبير عن ذوق الشعب ومشاعره وعقليته وهمومه ومطامحه، كالأمثال والأحاجي والأشعار والقصص والأغاني والمرددات وما إليها مما طغى عليه التداول بالشفاه.
إن الثقافة المغربية بهذه الأبعاد تتجلى في مظاهر متعددة يمكن إجمالها في المحاور الأربعة الآتية:
1ـ العلوم والمعارف والآداب بدءا مما تداوله العلماء والأدباء، إلى ما ألفوا من مدونات تضمها الخزائن العامة والمكتبات الخاصة.
2ـ الآثار المعمارية والمنشآت التاريخية الممثلة في المساجد والقلاع والقصبات والقصور والأسوار، وما إليها من تراث معروض في المتاحف غالبا ما يعد من مظاهر الحضارة.
3 ـ التعبير الشفوي بشتى ألوانه وأشكاله وأدواته، من شعر وأمثال وأحاج وقصص وحكايات.
4 ـ الفنون على اختلاف أنماطها وأدواتها، من موسيقى ورسم وتشكيل ومسرح ورقص.
وليس غريبا أن يكون لهذه الفنون في الثقافة المغربية ـ ولا سيما منها الرقص والغناء ـ مجال عريض باعتبارها داخلة في صميم حياة الأفراد والمجتمع، ومكونة لحيز كبير من الممارسات الخاصة والعامة التي تعتمد التوقيع الحاد القائم على آلات القرع والتصفيق والضرب بالأقدام في غالب الأحيان، في تعبير مباشر تارة ورمزي أخرى، وفي إطار يلتقي فيه الجميل بالوظيفي، وفي ارتباط وثيق بمواسم دينية ومناسبات اجتماعية، وكذا بالظروف الاقتصادية والفلاحية.
وللكلمة في هذه الفنون موقع يكاد يكون ثانويا، كما هو الشأن في موسيقى الآلة التي وفدت من الأندلس وأضاف إليها المغاربة، والتي تعد في طليعة فنونهم الموسيقية. على أن موقع الكلمة يبرز في بعض الأنماط المنبعثة أساسا من الإبداع الشعري كالملحون وما إليه من أغان يتوسل فيها بألحان مقتبسة من إيقاعات " الآلة
كما أن لفنون أخرى ـ كالرسم ـ توجها يربطها بالمعتقدات القديمة، على نحو ما يظهر في الوشم على سبيل المثال، وإن كان للإسلام موقف منه واضح. وبحكم هذا الموقف، لم يعن بكل فن يقوم على التجسيم ـ كالنحت ـ ووقع الاعتماد على التقسيمات الهندسية التي تظهر في تشكيل الزليج والحفر في الخشب والجبس.
وليس يستغرب مثل هذا الموقف، فهو مجرد ملمح بسيط يضم إلى ملامح أخرى كثيرة سبقت الإشارة إلى بعضها، تؤكد أن الثقافة المغربية في جانبيها المدرسي والشعبي تستمد باستمرار من الإسلام، باعتباره ـ كما سبقت الإشارة إلى ذلك ـ ليس فقط عقيدة دينية، ولكن باعتباره كذلك شريعة لها نظمها ومناهجها، ثم باعتباره مجموعة من القيم السلوكية والقواعد الخلقية، وما ينتج عن ذلك كله من فكر، وما يترتب من عقلية ونفسية، وما يتبلور من فلسفة للحياة متميزة بمفاهيم ورؤى وتصورات ومواقف.
وليس يعني استثناء المكون الأجنبي إبعاده وعدم الاعتراف به عنصرا فاعلا في الثقافة المغربية،وإنما يعني أنه دخيل ، على الرغم من كونه لصيقا بالواقع المغربي، وعلى الرغم من أنه غدا ضروريا في الحياة المعاصرة. ويعني كذلك أنه يحتاج لامتصاصه والإفادة منه، أ، ينطلق التعامل معه بوعي وبصيرة، إن لم نقل بحذر وحيطة، وأن يقوم هذا التعامل على أساس من التشبع بروح الثقافة العربية الإسلامية، والاعتزاز بها، وتمثلها في مختلف مناحي الحياة، والرغبة في تلقيحها بما عند الآخرين.وهي شروط تقتضي الإلحاح عليها، نظرا للقابلية التي يتمتع بها المغاربة للتطلع إلى الجديد، والتكيف معه والتلاؤم، إلى حد الاندماج فيه. وهي ظاهرة حميدة ما لم تكن على حساب المقومات الذاتية التي لا تحفظ إلا إذا قوي التمسك بالأصول واشتد الارتباط بالجذور.
ثانيا: الملامح، ونستطيع إبراز أهمها فيما يلي :
1ـ أن الثقافة المغربية في نمطيتها كانت قائمة على العلوم الدينية،في اعتماد على الفقه والتصوف، ومستندة إلى اللغة وعلومها من نحو وصرف، في غير إهمال للعلوم البحتة التطبيقية، وكذا للفنون الأدبية التي كانت العناية بها دراسة وإنشاء تأتي تكميلية لغيرها، مما جعل الثقافة في المفهوم العام ترتبط بالعلم والشرعي منه على الخصوص، ومما جعل القائمين عليها هم في الغالب من العلماء والفقهاء والطلاب الراغبين في تحصيل هذا العلم، وإبراز هذا التحصيل بالاستذكار والاستظهار، مما لم يتح مجال الإبداع فيه إلا عند قلة وفي حدود ضيقة.
2 ـ أن مؤسساتها كانت هي الكتاب _))لمسيد أو لحضار ( والمسجد والزاوية ، وأن هذه المؤسسات ـ وهي في جلها وقفية ـ كانت إلى جانب نهوضها بمهمة التربية والتعليم تشكل بنيات للثقافة، أي لممارسة أنشطة هذه الثقافة، لا سيما في المواسم والمناسبات. ومثلها بنيات أخرى يمكن أن نذكر من بينها خزائن الجوامع ومجالس الملوك والأمراء وأندية العلماء والأدباء حيث تلتقي فئة معينة من المثقفين،إضافة إلى الساحات العمومية وما كان يقام فيها من حلق شعبية يتردد عليها عموم المواطنين
3 ـ أنها بذلك لم تكن مركزية، أي مقصورة على الحواضر التي غدت مؤسساتها معالم ثقافية ـ على نحو ما كان بجامع القرويين في فاس ومسجد ابن يوسف في مراكش ـ ولكنها كانت معممة في القرى والبوادي. وربما كانت الثقافة المنتشرة خارج الحواضر أقرب إلى التوسع والتفتح، لبعدها قليلا أو كثيرا عن الطابع الأكاديمي الذي كان يستبد بتلك .
4ـ أنها في تلقيه وتوصيلها كانت تتوسل بالدرس والخطابة والوعظ، في اعتماد على مقررات ومناهج ترتكز على الحفظ والترديد، لا سيما والكتب قليلة وغير ميسرة التداول إلا ما كان من بعض المتون والشروح التي كان يختطها الطلاب والمدرسون.
5 ـ أن مروجيها ـ إبداعا وتلقينا ـ كانوا ينتمون إلى مستويات اجتماعية متفاوتة، وأنهم بحكم اقترابهم أو ابتعادهم من النخبة أو العوام، كانوا يوظفون ثقافتهم لأهداف غالبا ما كانت ترتبط بأعمال لم تكن تتجاوز التدريس والقضاء والعدالة وبعض المهام الدينية، كالإمامة والخطابة؛ وربما بوأت بعض البارزين مناصب عليا، كالوزارة أو الكتابة في الدواوين الرسمية.
6 ـ أنها كانت تتسم بشيء من الحرية والتلقائية جعلها لا تخضع لمشروع ثقافي صارم، على غرار ما كان استثناء في العهد الموحدي،وحتى المرابطي قبله مع تباين في الاتجاه. ومن ثم عاشت استقلالية كانت تبلغ في معظم الأحيان حد الشعور بالتهميش الذي كان يفضي إلى ضعف إمكانات صنع الثقافة، إذ غالبا ما يبقى هذا الصنع رهين جهود فردية محدودة.
7 ـ أنها على الرغم من ذلك لم تكن بعيدة عن واقع الحياة المتحرك وما يتطلبه من مواقف، بل كانت تشكل سلطة تقف إلى جانب سلطات أخرى تتحالف معها أو تواجهها، وقد تتصارع معها؛ وأهمها السلطة السياسية وسلطة المجتمع. فبالنسبة للمجتمع كان المثقفون في الغالب على احتكاك به وبقضاياه، إضافة إلى مسؤولية توجيهه. وكان للفقهاء والمتصوفة على الخصوص دور كبير في هذا المجال. أما السياسة فإنها باستثناء ما كان في العهدين المرابطي والموحدي لم تتح إلا للفئة التي يمثلها الكتاب والشعراء الرسميون ومن إليهم من المؤدبين والمؤرخين ، وكذا بعض أرباب الفنون والصنائع الماهرين، إلى جانب من كانوا من الوزراء والسفراء ينتمون إلى عالم الثقافة. ومن ثم كان المثقفون متأرجحين بين الانعزالية عن المجتمع والسياسة، وبين الانصهار في المجتمع ، وبين الانحياز للسياسة. وقليلون هم الذين تسنى لهم التوفيق بين جميع هذه السلطات بحكمة وتوازن وإدراك واع لرسالتهم الحق.
8 ـ على هذا النحو كانت ثقافتنا خلال التاريخ تتأرجح بين سكونية تربطها بالماضي ونصوص الموروث، وبين حركية تشدها إلى واقع المجتمع وراهن قضاياه، مما جعلها في الممارسة تتأرجح بين الفعل ورده. ولا يخفى أن الحديث عن الواقع يعني التفاعل السياسي والاجتماعي بوعي ونقد، وبقدرة على إثارة الأسئلة الصميمية حول الحاضر والمستقبل، وحتى الماضي، برؤى ذاتية قادرة على إحداث التطوير والتغيير. وهو ما لا يمكن أن يتحقق بدون إبداع مشروع ثقافي يستجيب بمرونته لذلك كله، انطلاقا من مفهوم واضح للثقافة إلى تحديد وظيفتها، ثم إلى إبراز الدور الذي على المثقفين أن ينهضوا به، وكذا الدور الذي على المواطنين أن يضطلعوا به، وللأوضاع العامة ـ والسياسية منها على الخصوص ـ أكبر تأثير على بلورة هذا المشروع، إن لم يكن على وجوده أو عدم وجوده.
9 ـ ومع كل ما كان يلابس هذه الثقافة من سلبيات ـ حسب منظورنا المعاصر ـ فإنها كانت تلبي حاجة المواطنين، وتشبع رغباتهم، وتستجيب لتطلعاتهم، إلى حد يمكن القول بأنهم كانوا ـ ولو في حدود ـ يمتلكونها ويتجاوبون معها ويهضمونها ويتذوقونها، وبالتالي كانوا يستفيدون منها ويمدونها بالعطاء، في سياق وحدة تبلورها مواطنة جامعة. وخلف هذه الحقائق كانت تكمن حصانة المواطنين أي حصانة فكرهم مما قد يزعجه أو يشوش عليه.
10 ـ وقد كانت هذه الحصانة تتحفز من مشاعر متجذرة تجليها صفات يمكن إجمالها في قوة الدين وشدة التمسك به عقيدة وشريعة ومنظومة سلوك، في حرص على أداء الفروض والطاعات، والسعي إلى ما يشيع الخير والنفع ويذيع المحبة والسلام؛ مع إحساس بالذات في كبرياء وكرامة تحثان على الاعتزاز بالحرية والسيادة، وعلى التشبث بالعرض والشرف، وعلى رفض الذل والخنوع وعدم قبول الضيم والظلم، وعلى مقاومة كل ألوان التسلط والعدوان، وعلى مواجهة جميع التحديات بشجاعة وصبر وتحمل وتضحية بكل شيء، في سبيل الدفاع عن الوطن والحفاظ على كل ما هو فيه غال وعزيز ومقدس.
ثم إن المغاربة كانوا ـ وكما يدل على ذلك تاريخهم منذ القديم ـ ميالين إلى ما هو ملموس محسوس، وما هو صحيح قوي، وما هو مجد نافع، أكثر من ميلهم إلى سبر أغوار الحقائق وتذوق أشكال الجمال. ولعل السبب في ذلك راجع إلى موقعهم الجغرافي والظروف التي انبثقت من هذا الموقع، وما اضطرتهم إليه من مواقف التحدي المستمر والمواجهة الدائمة، وما نشأ عن هذا كله من تجارب، وما ولدت هذه التجارب من قيم عبرها كانوا ينظرون إلى الحياة والناس، أي كانوا من خلالها يكونون ذهنيتهم وفلسفتهم.
ومن هنا لا شك كان التمسك بالحرية مظهرا أساسيا من مظاهر هذه الفلسفة، بكل ما تفضي إليه الحرية من اعتزاز بالذات ورغبة في الاستقرار وفي السلام كذلك.
وإن هذه الملامح الخصوصية لتكشف عن ارتباط وثيق بالماضي، وتوق دائم إلى المجد الغابر والرغبة في تذكره واستحضاره وإحيائه، مما ينم عن متانة الأصول وما تجذر بها وتولد عنها من موروثات، كانت على الدوام بفضل تواصل حلقاتها المتماسكة تكيف واقع المغرب ووجوده ومنطق تاريخه.
إن البحث عن هذه الأصول لا يعني ارتماء في أحضان الماضي للتغني به أو الهروب إليه، لعجز عن مواجهة الحاضر والنظر إلى المستقبل، ولكنه يعني إدراكا واعيا للحاضر وتطلعا ملحا لاستشراف المستقبل، على أساس استخلاص هذه الأصول، باعتبارها مصدر الذات ومرجعها، ثم باعتبارها أسسا ودعائم يمكن الارتكاز عليها لمواصلة البناء الثقافي وتجديده وتقويته، بعيدا عما يعلوها من غبار، أو يخالطها من شوائب تراكمت عليها بفعل الزمن وشتى ظروفه ووقائعه.ثم إن تأمل هذه الأصول يفضي إلى إدراك حقيقة الثقافة المغربية، أي الثقافة الجامعة الموحدة التي تغتني بالروافد الفرعية كيفما كان نوعها وكانت محليتها، والتي بها يكون التجانس الذي يقوي الكيان.
ومتى قوي الكيان، تحقق استمرار الذات والإرادة، ومعه استمرار حق الإنسان في الحياة العزيزة الكريمة، واستمرار سموه على كل مظاهر الكون والطبيعة، واستمرار قدرته على مواجهة جميع التحديات التي تعترض
على أنه لا معنى لهذا التأمل في الأصول إن لم يقترن بالتمسك بها، لأن هذا التمسك هو الذي سيمكن المغرب من البقاء والقدرة على فرض هذا البقاء بكيان موحد وقوي، وهو الذي سيتيح له المساهمة في الثقافة الإنسانية، والنهوض فيها بدور فعال به يكون المغرب جديرا بحياة عزيزة كريمة وسط زوابع العصر وصراعاته وما يعتمل فيه من نزعات ونعرات .
وإن إثارة مثل هذا الموضوع ليكتسي بالغ الأهمية في المرحلة المعاصرة التي تعاني فيها الثقافة المغربية سلبيات تسربت من عهد الاستعمار، وفرضت عليها التقليص والعزلة والانكماش والتمزق والصراع مع غيرها،في قلق وحيرة وشك ونزاع داخل الذات والإرادة. وهي كلها ظواهر تفضي إلى التفكك الثقافي الذي لا يؤدي إلا إلى التخلف، والذي لا مخرج منه إلا بالتشبث بالثقافة في أصولها الثابتة، أي بثقافة مغربية عربية إسلامية.
إن التمسك بهذه الثقافة في أصولها المغربية العربية الإسلامية، وما يغني هذه الأصول من روافد مختلفة محلية أصيلة أو متسربة دخيلة، لهو الضمان للحفاظ على هوية المغرب وقوة كيانه وتميز شخصيته وتفرد ذاته. وضمن ذلك وبسببه يكون الحفاظ على وحدته الترابية والفكرية والشعورية؛ وهي الوحدة التي التحمت بنياتها على امتداد أربعة عشر قرنا بعفوية وتلقائية وبرباط مقدس متين.
وإن هذه الثقافة بكل مكوناتها وروافدها ومقوماتها ـ وفي طليعتها اللغة ـ ستبقى كما كانت هي لحمة التواصل بين جميع المنتسبين لأقطار العروبة، والأداة الحافزة لهم إلى لم الشمل وجمع الكلمة، والسلاح الذي به يستطيعون مواجهة كل التحديات التي تعترضهم، على الرغم من اختلاف أنظمة الحكم وما يتبعها من مذاهب سياسية واقتصادية
ثم إن هذه الثقافة بحمولتها الدينية وبلغتها القرآنية، هي أقوى رباط وأمتن وسيلة للتواصل بين شعوب الأمة الإسلامية، مهما تعددت انتماآتها الجنسية، وتنوعت ثقافاتها، وتباينت اتجاهاتها في شتى المجالات.
ويبقى في نهاية المطاف أن الهدف البعيد من إثارة قضية أصول الثقافة المغربية هو إبداع ثقافة تكون قادرة على أداء الوظيفة التي على كل ثقافة حية أن تؤديها وتتلخص متطلبات هذه الوظيفة في الآتي :
1 ـ ترسيخ الشعور بالهوية وتثبيته في اقتناع بها واعتزاز، وفي حرص عليها يقود إلى التمسك والتشبث بها والدفاع عنها والاستماتة من أجلها.
2 ـ تنمية الملكات وإغناء المؤهلات وتقوية القدرات بما يمكن من إمداد هذه الثقافة وتطويرها.
3 ـ الحث على ممارسة إنسانية المواطن ، أي بأداء واجباته،والتمتع بحقوقه،وإثبات حضوره،وإتاحة فرص المساهمة في تقدم الوطن، والإفادة من هذا التقدم بعدل وإنصاف.
4 ـ تحديد السلوك الفردي والجماعي ، وبلورة المفاهيم والقيم التي ينبني عليها هذا السلوك، والتي على أساسها تضبط الأفعال والانفعالات، وتقام العلاقات الخاصة والعامة بإدراك واع وحوار مفتوح.
5 ـ اعتبارها مرجعية منها يكون الانطلاق وإليها تكون العودة، مما تصبح به الموئل والملاذ في جميع الظروف والأحوال
إن لكل بلد ما يميزه في المجال المادي، كالعمارة وما إليها من منشآت غالبا ما تدخل في نطاق الحضارة، كما أن له في الميدان الأدبي ما يطبعه من خصائص تبرزها المفاهيم والأفكار والقيم وما يرتبط بها من مبدعات وأنماط سلوكية وممارسات واعية أو عفوية، وما تعكسه من عادات وتقاليد وما إليها من نظم اجتماعية وغيرها،هي التي اعتاد الناس أن يطلقوا الثقافة؛وإن كنا لا نرى ما يبرر هذا التفريق، لما بين الحضارة والثقافة من تداخل وتكامل.
ومن ثم يمكن القول بأن الثقافة وهي ظاهرة طبيعية، تتضمن مجموع العناصر الإنسانية التي تشكل فكر الإنسان وسلوكه وتضبط علاقاته مع غيره، أي مع الكون والحياة والناس.وهي عناصر تكتسب بالتعلم والممارسة، إلى جانب ما يتوارث بالفطرة والغريزة، في تمايز بين المجتمعات، وقابلية وللتواصل والاحتكاك،وتبادل التأثر والتأثير، وقدرة على صنع هذه العناصر وإخضاعها تلقائيا للحاجات بالتكييف والتطوير والتغيير.
إن الثقافة بهذا نشاط إنساني وفعالية تحرك الوجود، في تفاعل يفضي إلى التنوع والتعدد، وإلى التباين والاختلاف، وفق معطيات مختلفة بيئية وفكرية ونفسية، وحتى جسمية،هي التي تتيح إنشاء ثقافة بخصوصيات معينة، قد تلتقي مع غيرها في تكامل يتحقق معه التماثل والوحدة، ومعهما تتسنى للأفراد والمجتمعات حياة ذاتية خاصة، وحياة عامة مشتركة من خلالها يكون التواصل والتعارف في نطاق ما يجمع من مصالح لازمة ومنافع ضرورية.
وعلى الرغم من أن مظاهر هذا النشاط ـ سواء في بعدها المادي أو الأدبي ـتتعرض عبر الأزمنة المتعاقبة لقليل أو كثير من التطوير وربما التغيير، فإنها تظل محتفظة بملامح ثابتة قد تتفرد بها دالة على طبيعة الإنسان الذي يتسم بها أو تتسم بها حياته، مما قد يؤدي في البحث الأنتروبولوجي بصفة خاصة إلى استنتاجات تصل إلى حد تحديد انتماء هذا الإنسان إلى جنس معين أو سلالة محددة.
بمثل هذه الأبعاد التي تكون للثقافة وغيرها يمكن استخلاص ملامح الشخصية في جوانبها المختلفة، والمقصود بها الملامح الثابتة وإن ثبوتا نسبيا بالقياس إلى السمات المتغيرة. وانطلاقا من تلك الملامح يمكن التمييز بين وشخصية وأخرى، أي بين مجتمع وآخر، وربما فرد وآخر؛ دون إغفال المقومات التي غالبا ما تطبع المنتمين إلى مجتمع بعينه، والتي تجعل منهم أصحاب تفكير تركيبي أو ذهنية ذاتية، وكذا أصحاب سلوك قد يتسم بالهدوء والاعتدال أ, الحدة والتطرف
ذلكم أن أي مجتمع يشكل لنفسه ثقافة تستجيب لحاجاته الفكرية والنفسية والاجتماعية . وبقدر ما تكون هذه الاستجابة تكون قوة الثقافة.وبقدر ما تكون مضامين هذه الثقافة متكاملة وهادفة لغايات، يكون اتجاه الثقافة في خط علمي عملي، أو في خط وهمي خرافي، وإن كانا معا يسعيان إلى تنظيم المعارف والعلاقات وأنماط الحياة المختلفة، وربطها جميعا بالمعتقدات التي يقع الاطمئنان إليها عند تفسير الخوارق التي تستعصي على إدراك البشر
وإن دراسة ثقافة ما لتقتضي التوسل بمناهج متعددة، تاريخية وإتنولوجية ولغوية ونفسية وأنتروبولوجيية،وخاصة منهج الأنتروبولوجيا الثقافية التي تدرس الظاهرة الثقافية من حيث مكوناتها وخصائصها وعلاقاتها بغيرها، وما عرفته من تطور خلال الأزمان، وفق معايير ومقاييس إذا ما حللت الثقافة في ضوئها أمكن التحفز من الماضي لاستشراف المستقبل.
وليس من شك في أن الثقافة في عمومها، ومن خلال تتبع شتى ظواهرها في بلد معين، تكشف مدى ملاءمة ما لهذا البلد من معطيات بيئية،مع ما يعتمل فيه من عناصر تاريخية،وكذا مع المقومات البشرية لساكنيه،وحاجتهم إلى التواصل وأدوات لهذا التواصل.
وقد يتجمع ذلك كله في الواقع الذي تصبح الثقافة اختزالا له ولعلاقة الإنسان به، عبر أشكال تعبيرية مختلفة مكتوبة وشفوية، ومن خلال تلك الأدوات وفي طليعتها اثنتان:
ـ اللغة،ليس فقط باعتبارها ألفاظا لها دلالات،ولكن باعتبارها رموزا تخفي مفاهيم ورؤى يختلف الكشف عنها من مجتمع لآخر، وربما من فرد لآخر، حسب القدرة على التفكير والإعراب عنه.
ـ المعتقد الذي هو في الحقيقة يشكل روح تلك الثقافة وجوهرها،والكل المتحكم في الأجزاء، مهما تكن هذه الأجزاء متنوعة ومتعددة وغنية خصيبة، ومهما تكن الشبكة التي تشكلها دقيقة ومتفرعة.
وإذا كانت هذه "الشبكة الثقافية" تبدو ملتئمة الخيوط ملتحمة النسيج، بعد فترات تفاعل ومراحل مخاض، عن طريق احتكاك قد يبلغ حد الصراع، فإن مرد ذلك إلى تمحورها حول نواة هي التي يمكن أن نعتبرها أصلا أو أصولا لتلك الثقافة؛ داخلها وانطلاقا منها يحدث التأقلم ويتحقق التوحد، أي يتشكل الكيان الذي يضم ما قد تمثله الثقافة في حال تنوع روافدها وتعدد فروعها، ومعه تتشكل ذات الجماعة وشخصية الأمة بعيدا عن أي مظهر للتشتت والانفصام أو التمزق والانقسام
وإضافة إلى ما يكون لهذه الأصول من رسوخ عميق في النفوس، وفي شتى محتويات الثقافة وأشكالها، فإنها تكون باستمرار حافزة إلى استحضارها وإحيائها والاستمداد منها، لا سيما عند الشعور بمضامين وأشكال ثقافية بعيدة عن تلك الأصول، تزعج وتهدد بتسرباتها البطيئة الخفية أو السريعة المكشوف
على أن الحديث عن الأصول لا يعني فقط الوصول إلى الجذور الأولية أو البدائية التي لا تنجلي بعض آثارها إلا بالحفر والتخمين، على أهمية هذه الجذور وإبراز ما لها من أثر، بقدر ما يعني كذلك الوقوف على الثوابت التي عبرتها مختلف موجات الحياة، وتعاقبت عليها شتى دورات النمو، فلم تزدها إلا غنى وقوة كانت بهما قادرة على امتصاص ما يوافقها وينسجم معها، وكذا على نفي ما يشوبها أو يتناقض معها؛ شأنها في ذلك شأن الجسم يرفض ما هو غريب عنه ودخيل، طالما أنه ينعم بالصحة والحيوية والمناعة، ويتمتع بإمكانات الصمود والاستمرار ولعل في قدرة هذه الثوابت على اكتساب الجديد الملائم لها ما يجعلها على الدوام تسير في خط الرقي والتقدم، غير ساكنة جامدة ولا منتكسة متخلفة.
وحين نوجه نظرنا نحو المغرب، فإننا لا نرى إمكان الحديث عنه في جميع شؤونه ومتعلقاته، ثقافية كانت أو غيرها، من غير أن نستحضر عنصرين اثنين: موقعه وسكانه
ـ أما الموقع فمحصور في أقصى شمال القارة الإفريقية، مطلا على بحرين عظيمين،أحدهما وهو الأطلسي لم يكن خلال التاريخ القديم سوى فضاء مظلم، والآخر وهو الأبيض المتوسط كان على الدوام معبرا بين الشرق والغرب ومجال حركة حضارية وثقافية مستمرة. والمغرب بانتمائه الإفريقي يبدو ممدود النظر واليد باستمرار للشرق من جهة، ولما بعد الصحراء من جهة أخرى؛ في حين يواجه في شماله قارة أروبية كان له مع بعض دولها كثير من الاحتكاك والصدام، في مد وجزر لم يعرف الانقطاع قط.
والمغرب بحكم هذا الموقع المحتوم وما يفرضه عليه، كان على امتداد الحقب يعاني تأرجحا إن لم نقل اضطرابا وحيرة بين الانفتاح على التيارات التي تهب عليه رياحها، وبين الانغلاق حماية لنفسه من الزوابع التي قد تصاحب هذه الرياح،مما جعله في نهاية الأمر يشعر بشيء من الانعزال عن المراكز التي كانت تظهر فيها الديانات،وتعتمل فيها الحضارات والثقافات، لا سيما الشرق
ـ وأما السكان، فلا نرى حاجة إلى أن نثبت أنهم من البربر الأمازيغ ومن العرب، بحكم اندماجهم داخل بوتقة الإسلام باعتباره رسالة إنسانية عالمية، وبدءا من عصره الأول، يكونون نسيجا مغربيا متلاحما ذابت فيه كل الفوارق وزالت به جميع العناصر الجزئية، إلا ما كان من بعض الخصوصيات الثقافية التي استطاع التشكيل الاجتماعي أن يهضمها ويدمجها أو يحتفظ بها ويغتني، كبعض العادات والممارسات وأنماط الفنون والآداب المنبعثة من إبداع اللهجات المحلية؛ دون أن ننسى أن أولئك البربر هم عرب في الأصل، إذ ليس يخفى أن المؤرخين ودارسي الأجناس والسلالات أثبتوا للعرب أصولا في إفريقيا الشمالية التي منها اتجهوا منذ العصرين الحجري القديم والحديث، أي قبل الميلاد بأزيد من عشرة آلاف عام،إلى شبه الجزيرة العربية، حيث استقروا بجنوبها في أول الأمر، مارين بمعبر السويس في مصر.كما أثبتوا الشبه بينهم وبين البربر، لا سيما فيما يتعلق بالملامح الخلقية الجنسية، وحتى اللغوية والفنية، إضافة إلى بعض العادات وما إليها من مظاهر اجتماعية. في حين يرى غير هؤلاء من علماء الحفريات، أن العرب هم الذين نزحوا منذ هذين العصرين إلى الشمال الإفريقي وافدين من شبه الجزيرة العربية، وأنهم اختلطوا عند وصولهم بشعوب أخرى كانت قادمة من أروبا عبر شبه الجزيرة الإيبيرية.
مهما يكن فإن أصل السكان المغاربة كامن في العروبة الحميرية التي تربطهم بشبه الجزيرة العربية، وكامن كذلك فيما يثبته الواقع التاريخي من اختلاط تواصل بفعل الهجرات العربية المشرقية المتعددة التي اتجهت نحو المغرب خلال العصور الإسلامية، لا سيما طوال القرون السبعة الأولى، ثم الهجرات الأندلسية التي عرفت أوجها على إثر انتهاء وجود الدولة الإسلامية في شبه الجزيرة الإيبيرية، تكون نسيج تشكلت به وحدة وطنية ودينية عاش المغاربة في ظلها مجتمعين، يتملكهم شعور بهذه الوحدة، هو الذي كان دائما يحثهم على التمسك بالأرض والدفاع عنها ورد كل محاولة للاعتداء عليها.
وفي بوتقة هذه الوحدة، تبلورت ملامح ثقافة مغربية كانت مسبوقة لا شك بشتى مظاهر الحياة البشرية التي عرفها المغرب في مراحل ما قبل التاريخ، على نحو ما أبرزته الاكتشافات الأثرية من عظام وأدوات وحلي ونقوش وكتابات تذكر في مضمونها بما كان عند قدماء المصريين من معتقدات،وتحيل في شكلها إلى لهجتهم التي تنتسب مثلها إلى المجموعة الكوشية أو الحامية، في قرابة مع الأصل السامي، وفي توسل بحروف التيفيناغ التي هي ذات مرجعية ليبية
وقد أتيح لهذه الثقافة أن تكتسب بعض الجديد في العهد الفينيقي الذي بدأ منذ منتصف القرن الثاني عشر قبل الميلاد، والذي استمر الاحتكاك به نحوا من ألف عام. وهو احتكاك قوى هذه الثقافة في سياق التوجه الشرقي الذي كانت تمتزج فيه مظاهر مصرية وأخرى إغريقية
وعلى الرغم من أن المغرب بعد الحروب البونيقية التي دارت بين القرطاجنيين والرومان، والتي دامت من منتصف القرن الثاني قبل الميلاد إلى منتصف الخامس بعده، تعرض للغزو الروماني، فإنه ظل محتفظا بطابع ثقافته التي حاول الغزاة أن يستبدلوا بها ثقافتهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك إلا في نطاق ضيق كانت تمثله فئة من المتعلمين والموظفين وأصحاب المصالح، هم الذين استعملوا اللغة اللاتينية واعتنقوا المسيحية.
ومع أن المغاربة ميالون إلى التوحيد، فإنهم لم يقبلوا على هذا الدين، لارتباطه بالاستعمار الروماني،إلا ما كان من تلك الفئة التي لم تلبث أن دخلت الإسلام، مما لم يبق معه للمسيحية أي أثر في المغرب. كما أنهم رفضوا اليهودية لارتباطها بالميز العنصري، وإن اعتنقتها مجموعة محدودة، أسلم معظمها، من غير أن يقضى على الدين اليهودي الذي استمر عند قلة من المغاربة لا تذكر، مما أتاح له أن يستمر عند هذه القلة، وكذا عند بعض اليهود الذين هاجروا إلى المغرب بعد أن طردوا من الأندلس ولم يسلموا، وحافظوا في نطاق دولته ـ باعتبارهم من الكتابيين أهل الذمة ـ على عقيدتهم وثقافتهم التي كانت في انعزالها ذات صيغة دينية، ولم يتسن لها أن تحتك بعموم الثقافة المغربية إلا من خلال بعض المهارات الصناعية وبعض الفنون، على نحو ما كان لهم من اعتناء في العصور المتأخرة بطرب الملحون وموسيقى الآلة التي كان لليهود فيها تبريز متميز.
ومن ثم، فإن المغاربة واجهوا كل تلك التحديات،وظلوا محافظين على ثقافتهم، وعبرها أثبتوا وجودهم الذي تمثل في بعض الإمارات المستقلة،والذي بقي صامدا في وجه الغزاة الوندال الذين جاءوا من جرمانيا، والذين استمر احتلالهم من منتصف القرن الخامس إلى منتصف السادس، وكانوا أهل تخريب وتدمير، في استبداد واستغلال للخيرات، مما جعل تأثيرهم الثقافي لا يذكر.وقد تعرض المغرب بعدهم للغزو البيزنطي الذي واجهه المغاربة بشدة، دون أن يفيدوا منه أي شيء
وهو وضع زاد في تعقيده غموض هذه الفترات التي اتسمت بشيء غير قليل من الاضطراب، والتي مهدت لاعتناق الإسلام وهو الدين الذي سيطبع مسيرة المغرب الثقافية بعد أن طبعها سياسيا وفكريا ولغويا.
وقد مر هذا الاعتناق قبل اكتماله بمراحل بدأت في منتصف القرن الهجري الأول، واستمرت نحو عقدين في القرن الثاني. وهي مراحل طالت بالقياس إلى ما عرفته الفتوحات في أقطار أخرى، لأسباب، من أهمها الموقف الذي للمغاربة في المنطلق من كل وافد يخشون اعتداءه واحتلاله ومسه لحريتهم واستقلالهم.وهو موقف زال بعد اطمئنانهم للدين الجديد، وارتياحهم لمبادئه وقيمه وانسجامهم مع الفاتحين.بل زادوا فكانوا في مقدمة حاملي دعوته إلى الأندلس والمجاهدين لتبليغها ونشرها في كل موقع، والدفاع عنها ورد خصومها بتحد وشجاعة قل لهما نظير
ولا يمكن الحديث عن التحام المغاربة بالإسلام، من غير أن يشار إلى ما كان لهم من اختيار مذهبي قوى هذا الالتحام.
وقد تم هذا الاختيار بعد اختبار لمختلف المذاهب التي عرفها المسلمون، سواء على مستوى السياسة أو العقيدة أو الفقه، بدءا من المذهب الخارجي الذي مال إليه المغاربة أول الأمر، إذ وجدوه يوافق طبيعتهم الاستقلالية ورفضهم لأي ميز عنصري، مما جعلهم يرحبون بأفواج من الخوارج ويتيحون لهم أن يستقروا في المغرب بعد أن هزموا في المشرق.فكان أن تقوى هذا المذهب في الاتجاه الصفري ، وظهر له زعماء مغاربة كميسرة المدغري. كما تكونت له إمارة هي إمارة بني مدرار في سجلماسة.
وقد كاد المغاربة أن يستقروا على الخارجية،لولا تعاطفهم مع آل البيت وانتصارهم لقضيتهم وما كانوا يعانونه من محن في المشرق. وهو ما تمثل في استقبالهم للمولى إدريس، ومبايعته بالإمارة في وليلي عام اثنتين وسبعين ومائة للهجرة، بعد أن تنازل له عنها عبد الحميد بن إسحاق الأوربي الذي حث القبائل على هذه المبايعة.
كذلك كان للاعتزال أثر واضح من خلال جماعة الواصلية التي كانت قبيلة أوربة على رأيها، في حين كان التوجه الفقهي قائما أول الأمر على أساس السنية، ثم وقع الأخذ بمذهب أبي حنيفة الذي هو مذهب أهل الكوفة، مع بعض التأثر بمذهب الأوزاعي الذي عرفته الأندلس بسبب أموية الدولة فيها، وهو مذهب أهل الشام. ولم يلبث المغاربة بعد هذا أن مالوا إلى مذهب مالك الذي هو مذهب أهل المدينة.
ونظرا لأن المغاربة في تجاوبهم مع الأحداث المشرقية كانوا يميزون بين المساندة السياسية والالتزام الفكري، فإنهم حتى وهم يمكنون للمولى إدريس الذي كان يتوقع نشر التشيع في عهده، ظلوا على سنيتهم المالكية، بل جعلوه يدرك هذه الحقيقة ويسير في خط هذه السنية
وعلى الرغم من الاضطراب السياسي والفكري الذي عاشه المغرب بعد انهيار مبكر للدولة الإدريسية،والذي انعكست سلبياته على الثقافة، فإن المذهب ظل مستمرا بحكم عوامل كثيرة، أهمها تمسك المغاربة به لانتمائه إلى عالم المدينة، وكذا رحلاتهم إلى الحجاز لأداء فريضة الحج، إضافة إلى موافقة مزاجهم وعقليتهم.
وقد تقوى هذا الاستمرار بسبب المساندة الرسمية له على امتداد الدول.وهي مساندة عرفت أوجها في عهد المرابطين الذين أنشأوا دولتهم في منتصف القرن الخامس الهجري على أساس من الإصلاح الديني قائم على الفقه المالكي، الذي كان يومئذ وحده القادر على جمع كلمة المغاربة،وتوحيدهم في خط فكري يستند إلى تثبيت قواعد الدين ومبادئه الأولية على نحو بسيط وواضح،ليس فقط على مستوى الفقه، ولكن كذلك على مستوى العقيدة التي أخذ المغاربة فيها بالاتجاه الأشعري الذي كان وسطا بين تيار المتكلمين القائلين بإعمال العقل والتأويل، وتيار السلف الذي كان له موقف من ذلك قائم على الإقرار بالمتشابهات.
وإذا كان المجال لا يتسع لاستيعاب كل ما يكمن خلف سنية المغاربة ومالكيتهم، فإنه لا بد من الإشارة إلى الاستثناء الذي عاشوه مع الموحدين الذين أقاموا دولتهم طوال القرن السادس الهجري على المذهب الذي ابتدعه المهدي بن تومرت، مازجا فيه بين مذاهب شتى، هي الشيعية الإمامية والاعتزال والظاهرية والأشعرية،والذي كان يسعى من ورائه إلى تحقيق هدف سياسي هو تقيض دولة المرابطين الفقهية
إلا أن المغاربة لم يلبثوا أن عادوا إلى ما هم مقتنعون به، في الاتجاه السني المالكي الذي حافظوا به على كيانهم الفكري داخل وحدة الدين
وإذا كانت هذه الوحدة قائمة على الإسلام، فليس فقط باعتباره عقيدة، ولكن باعتباره كذلك نظاما متكاملا تشكل عند المغاربة في النظرية والتطبيق من خلال النموذج السني الذي هو أقرب إلى الصورة النبوية المثلى، وكذا باعتباره فكرا يتوسل بلغة القرآن. ومن ثم استطاع الإسلام أن يحتوي ما كان شائعا من شتى مظاهر العصبية والقبلية ومختلف عوامل التشتيت والتفريق.
وإدراكا لذلك، وربطا للوطنية والسيادة بالإطار الإسلامي، كان التمسك بالإسلام وبالإمامة الشرعية التي جعلت المغاربة منذ تمكينهم للمولى إدريس، يضعون الإمام فوق جميع الاعتبارات
لقد كان لتمسك المغاربة بالحكم الشرعي لسلطة الإمام أثر كبير في توجيه مسيرهم الثقافي، ويبدأ هذا الحكم باعتبار العلم أساسا في اختيار الإمام، إلى جانب شروط أخرى هي الكفاية والعدالة والقرشية وسلامة الحواس.
وقد بلغت العناية بشرط العلم مكانة وصل بها بعض الملوك المغاربة إلى درجة الاجتهاد والتجديد، في حين وقع مس بعضهم ممن لم يتوافر فيهم هذا الشرط على النحو المطلوب، كيوسف بن تاشفين الذي كانت لخصومه وخصوم المغرب دوافع عمقت نظرهم إلى هذه المسألة.
إذا نحن في ضوء هذه المعطيات الأساسية وغيرها مما تسعف به حقائق التاريخ الذي التأم عبره نسيج الوحدة الوطنية، حاولنا أن نتأمل الثقافة المغربية في أهم العناصر التي يمكن اعتبارها دعائم أصلية لها، فإننا سنقف على المكونات والملامح الآتية:
أولا : المكونات، ويمكن حصرها أساسا في ثلاثة :
1ـ الموروث البربري الذي تداوله المغاربة قرونا قبل دخول الإسلام، والذي ما زال ينبض في القلوب ويتدفق فيها بحيوية.
2ـ الرصيد العربي الإسلامي بمقوماته الشرقية والأندلسية والإفريقية.وهو ر صيد أمد هذا الموروث، وأغناه وقواه، ووسع مجالاته، وأكسبه سمات متجددة، وفتح له آفاقا رحبة وصلته مع ثقافة الأمة العربية الإسلامية بأواصر متينة غدا بها وبمساهمته في تمتينها أحد أركان هذه الثقافة، وملمحا متميزا فيها، بقابلية نادرة للأخذ والعطاء.
3 ـ التيارات الوافدة التي أتاحها الموقع الجغرافي والواقع المتطور الناتج عنه، ويغلب عليها الجانب الأروبي، والفرنسي والإسباني منه على الخصوص بحكم علاقات مختلفة تاريخية في مجملها، فرضت ألوانا من الاحتكاك في مد وجزر كانت لهما ردود فعل مختلفة، كما أتاحت كثيرا من مظاهر التأثر لا تخلو من إيجابيات، تسنى بها شيء من التفتح على العالم وبعض التحديث كذلك، وإن كانت لا تخلو أيضا من سلبيات تتضمن عناصر مدسوسة وملغومة.
وإذا نحن استثنينا هذا المكون الثالث الأجنبي، فإننا سنجد أن المكونين الأول والثاني شكلا على امتداد أربعة عشر قرنا ثقافة مغربية توسلت بلغة القرآن، أداة لها تكتسب بها العلوم والآداب والفنون، وتبدع بها في مختلف هذه المجالات، مما لا حاجة إلى التوسع في إبرازه. وقد ساهم المثقفون المغاربة في إغنائه، بغض النظر عن انتماآتهم الإقليمية أو لهجاتهم المحلية، عربية وبربرية، مع الإشارة إلى أنه وقع التوسل بالبربرية مكتوبة بالحرف العربي في تحرير بعض المسائل الفقهية، لتقريبها إلى بعض الناطقين بها من الذين لا يحسنون استعمال العربية، على نحو ما تكشف بعض المدونات؛ ومع الإشارة كذلك إلى أن المهدي بن تومرت، بدافع تحقيق أهدافه السياسية، لجأ إلى البربرية وسيلة للاتصال بالجماهير والتأثير عليها، فدرس بها وألف بها كتبه في المذهب، وزاد فأمر باستعمالها في الشؤون الدينية، كالخطابة والنداء للصلاة.
وتتضمن الثقافة المغربية إلى جانب هذا المجال المدرسي، مجالا آخر هو المتمثل في الإبداع الشعبي الذي هو التعبير عن نفسية الشعب ومفتاح شخصيته، وهو ثمرة إنتاج أفراده وجماعاته على الأجيال وفي شتى الميادين. به أثبت وجوده وقدرته على تأكيد الذات وممارسة جميع متطلبات هذه الذات. ويمثل إحدى النوافذ المهمة التي منها يمكن الإطلال على الثقافة المغربية وأصول هذه الثقافة، لاتخاذها قاعدة لثقافة وطنية ؛ إضافة إلى أنه خير وسيلة لإشراك الشعب في تأسيس هذه الثقافة، وإلى أنه يتضمن طاقات للاستلهام والاستيحاء والتطوير. ويتجلى في العادات والتقاليد باعتبارها مظاهر سلوكية تداخل حياة الناس والمجتمع، وتتحكم في العلاقات، وفي التعامل مع ظواهر الكون والحياة وتفسيرها، انطلاقا من طقوس ومعتقدات مترسبة، وبدون وعي في الغالب. وهي التي توجه الإنسان في شتى أطواره ومجالات حركته ونشاطه وتصرفاته. كما يتجلى في الفنون التي تتوسل بالحركة والإشارة والإيقاع ، كالموسيقى والرقص والألعاب، وبالعمل اليدوي الدقيق، على غرار الرقم والرسم والتزويق والزخرفة، وما إليها جميعا من أنماط رافقت الإنسان منذ مراحل حياته الأولى. بها حكى قصة وجوده،وعبر عن مختلف تلك المراحل، وبها عبر كذلك عن أفراحه وأحزانه وقيمه وشتى مواقفه. ثم هو يتجلى في الأدب الذي يشمل جميع الأنماط الفنية التي تتوسل بالكلمة في التعبير عن ذوق الشعب ومشاعره وعقليته وهمومه ومطامحه، كالأمثال والأحاجي والأشعار والقصص والأغاني والمرددات وما إليها مما طغى عليه التداول بالشفاه.
إن الثقافة المغربية بهذه الأبعاد تتجلى في مظاهر متعددة يمكن إجمالها في المحاور الأربعة الآتية:
1ـ العلوم والمعارف والآداب بدءا مما تداوله العلماء والأدباء، إلى ما ألفوا من مدونات تضمها الخزائن العامة والمكتبات الخاصة.
2ـ الآثار المعمارية والمنشآت التاريخية الممثلة في المساجد والقلاع والقصبات والقصور والأسوار، وما إليها من تراث معروض في المتاحف غالبا ما يعد من مظاهر الحضارة.
3 ـ التعبير الشفوي بشتى ألوانه وأشكاله وأدواته، من شعر وأمثال وأحاج وقصص وحكايات.
4 ـ الفنون على اختلاف أنماطها وأدواتها، من موسيقى ورسم وتشكيل ومسرح ورقص.
وليس غريبا أن يكون لهذه الفنون في الثقافة المغربية ـ ولا سيما منها الرقص والغناء ـ مجال عريض باعتبارها داخلة في صميم حياة الأفراد والمجتمع، ومكونة لحيز كبير من الممارسات الخاصة والعامة التي تعتمد التوقيع الحاد القائم على آلات القرع والتصفيق والضرب بالأقدام في غالب الأحيان، في تعبير مباشر تارة ورمزي أخرى، وفي إطار يلتقي فيه الجميل بالوظيفي، وفي ارتباط وثيق بمواسم دينية ومناسبات اجتماعية، وكذا بالظروف الاقتصادية والفلاحية.
وللكلمة في هذه الفنون موقع يكاد يكون ثانويا، كما هو الشأن في موسيقى الآلة التي وفدت من الأندلس وأضاف إليها المغاربة، والتي تعد في طليعة فنونهم الموسيقية. على أن موقع الكلمة يبرز في بعض الأنماط المنبعثة أساسا من الإبداع الشعري كالملحون وما إليه من أغان يتوسل فيها بألحان مقتبسة من إيقاعات " الآلة
كما أن لفنون أخرى ـ كالرسم ـ توجها يربطها بالمعتقدات القديمة، على نحو ما يظهر في الوشم على سبيل المثال، وإن كان للإسلام موقف منه واضح. وبحكم هذا الموقف، لم يعن بكل فن يقوم على التجسيم ـ كالنحت ـ ووقع الاعتماد على التقسيمات الهندسية التي تظهر في تشكيل الزليج والحفر في الخشب والجبس.
وليس يستغرب مثل هذا الموقف، فهو مجرد ملمح بسيط يضم إلى ملامح أخرى كثيرة سبقت الإشارة إلى بعضها، تؤكد أن الثقافة المغربية في جانبيها المدرسي والشعبي تستمد باستمرار من الإسلام، باعتباره ـ كما سبقت الإشارة إلى ذلك ـ ليس فقط عقيدة دينية، ولكن باعتباره كذلك شريعة لها نظمها ومناهجها، ثم باعتباره مجموعة من القيم السلوكية والقواعد الخلقية، وما ينتج عن ذلك كله من فكر، وما يترتب من عقلية ونفسية، وما يتبلور من فلسفة للحياة متميزة بمفاهيم ورؤى وتصورات ومواقف.
وليس يعني استثناء المكون الأجنبي إبعاده وعدم الاعتراف به عنصرا فاعلا في الثقافة المغربية،وإنما يعني أنه دخيل ، على الرغم من كونه لصيقا بالواقع المغربي، وعلى الرغم من أنه غدا ضروريا في الحياة المعاصرة. ويعني كذلك أنه يحتاج لامتصاصه والإفادة منه، أ، ينطلق التعامل معه بوعي وبصيرة، إن لم نقل بحذر وحيطة، وأن يقوم هذا التعامل على أساس من التشبع بروح الثقافة العربية الإسلامية، والاعتزاز بها، وتمثلها في مختلف مناحي الحياة، والرغبة في تلقيحها بما عند الآخرين.وهي شروط تقتضي الإلحاح عليها، نظرا للقابلية التي يتمتع بها المغاربة للتطلع إلى الجديد، والتكيف معه والتلاؤم، إلى حد الاندماج فيه. وهي ظاهرة حميدة ما لم تكن على حساب المقومات الذاتية التي لا تحفظ إلا إذا قوي التمسك بالأصول واشتد الارتباط بالجذور.
ثانيا: الملامح، ونستطيع إبراز أهمها فيما يلي :
1ـ أن الثقافة المغربية في نمطيتها كانت قائمة على العلوم الدينية،في اعتماد على الفقه والتصوف، ومستندة إلى اللغة وعلومها من نحو وصرف، في غير إهمال للعلوم البحتة التطبيقية، وكذا للفنون الأدبية التي كانت العناية بها دراسة وإنشاء تأتي تكميلية لغيرها، مما جعل الثقافة في المفهوم العام ترتبط بالعلم والشرعي منه على الخصوص، ومما جعل القائمين عليها هم في الغالب من العلماء والفقهاء والطلاب الراغبين في تحصيل هذا العلم، وإبراز هذا التحصيل بالاستذكار والاستظهار، مما لم يتح مجال الإبداع فيه إلا عند قلة وفي حدود ضيقة.
2 ـ أن مؤسساتها كانت هي الكتاب _))لمسيد أو لحضار ( والمسجد والزاوية ، وأن هذه المؤسسات ـ وهي في جلها وقفية ـ كانت إلى جانب نهوضها بمهمة التربية والتعليم تشكل بنيات للثقافة، أي لممارسة أنشطة هذه الثقافة، لا سيما في المواسم والمناسبات. ومثلها بنيات أخرى يمكن أن نذكر من بينها خزائن الجوامع ومجالس الملوك والأمراء وأندية العلماء والأدباء حيث تلتقي فئة معينة من المثقفين،إضافة إلى الساحات العمومية وما كان يقام فيها من حلق شعبية يتردد عليها عموم المواطنين
3 ـ أنها بذلك لم تكن مركزية، أي مقصورة على الحواضر التي غدت مؤسساتها معالم ثقافية ـ على نحو ما كان بجامع القرويين في فاس ومسجد ابن يوسف في مراكش ـ ولكنها كانت معممة في القرى والبوادي. وربما كانت الثقافة المنتشرة خارج الحواضر أقرب إلى التوسع والتفتح، لبعدها قليلا أو كثيرا عن الطابع الأكاديمي الذي كان يستبد بتلك .
4ـ أنها في تلقيه وتوصيلها كانت تتوسل بالدرس والخطابة والوعظ، في اعتماد على مقررات ومناهج ترتكز على الحفظ والترديد، لا سيما والكتب قليلة وغير ميسرة التداول إلا ما كان من بعض المتون والشروح التي كان يختطها الطلاب والمدرسون.
5 ـ أن مروجيها ـ إبداعا وتلقينا ـ كانوا ينتمون إلى مستويات اجتماعية متفاوتة، وأنهم بحكم اقترابهم أو ابتعادهم من النخبة أو العوام، كانوا يوظفون ثقافتهم لأهداف غالبا ما كانت ترتبط بأعمال لم تكن تتجاوز التدريس والقضاء والعدالة وبعض المهام الدينية، كالإمامة والخطابة؛ وربما بوأت بعض البارزين مناصب عليا، كالوزارة أو الكتابة في الدواوين الرسمية.
6 ـ أنها كانت تتسم بشيء من الحرية والتلقائية جعلها لا تخضع لمشروع ثقافي صارم، على غرار ما كان استثناء في العهد الموحدي،وحتى المرابطي قبله مع تباين في الاتجاه. ومن ثم عاشت استقلالية كانت تبلغ في معظم الأحيان حد الشعور بالتهميش الذي كان يفضي إلى ضعف إمكانات صنع الثقافة، إذ غالبا ما يبقى هذا الصنع رهين جهود فردية محدودة.
7 ـ أنها على الرغم من ذلك لم تكن بعيدة عن واقع الحياة المتحرك وما يتطلبه من مواقف، بل كانت تشكل سلطة تقف إلى جانب سلطات أخرى تتحالف معها أو تواجهها، وقد تتصارع معها؛ وأهمها السلطة السياسية وسلطة المجتمع. فبالنسبة للمجتمع كان المثقفون في الغالب على احتكاك به وبقضاياه، إضافة إلى مسؤولية توجيهه. وكان للفقهاء والمتصوفة على الخصوص دور كبير في هذا المجال. أما السياسة فإنها باستثناء ما كان في العهدين المرابطي والموحدي لم تتح إلا للفئة التي يمثلها الكتاب والشعراء الرسميون ومن إليهم من المؤدبين والمؤرخين ، وكذا بعض أرباب الفنون والصنائع الماهرين، إلى جانب من كانوا من الوزراء والسفراء ينتمون إلى عالم الثقافة. ومن ثم كان المثقفون متأرجحين بين الانعزالية عن المجتمع والسياسة، وبين الانصهار في المجتمع ، وبين الانحياز للسياسة. وقليلون هم الذين تسنى لهم التوفيق بين جميع هذه السلطات بحكمة وتوازن وإدراك واع لرسالتهم الحق.
8 ـ على هذا النحو كانت ثقافتنا خلال التاريخ تتأرجح بين سكونية تربطها بالماضي ونصوص الموروث، وبين حركية تشدها إلى واقع المجتمع وراهن قضاياه، مما جعلها في الممارسة تتأرجح بين الفعل ورده. ولا يخفى أن الحديث عن الواقع يعني التفاعل السياسي والاجتماعي بوعي ونقد، وبقدرة على إثارة الأسئلة الصميمية حول الحاضر والمستقبل، وحتى الماضي، برؤى ذاتية قادرة على إحداث التطوير والتغيير. وهو ما لا يمكن أن يتحقق بدون إبداع مشروع ثقافي يستجيب بمرونته لذلك كله، انطلاقا من مفهوم واضح للثقافة إلى تحديد وظيفتها، ثم إلى إبراز الدور الذي على المثقفين أن ينهضوا به، وكذا الدور الذي على المواطنين أن يضطلعوا به، وللأوضاع العامة ـ والسياسية منها على الخصوص ـ أكبر تأثير على بلورة هذا المشروع، إن لم يكن على وجوده أو عدم وجوده.
9 ـ ومع كل ما كان يلابس هذه الثقافة من سلبيات ـ حسب منظورنا المعاصر ـ فإنها كانت تلبي حاجة المواطنين، وتشبع رغباتهم، وتستجيب لتطلعاتهم، إلى حد يمكن القول بأنهم كانوا ـ ولو في حدود ـ يمتلكونها ويتجاوبون معها ويهضمونها ويتذوقونها، وبالتالي كانوا يستفيدون منها ويمدونها بالعطاء، في سياق وحدة تبلورها مواطنة جامعة. وخلف هذه الحقائق كانت تكمن حصانة المواطنين أي حصانة فكرهم مما قد يزعجه أو يشوش عليه.
10 ـ وقد كانت هذه الحصانة تتحفز من مشاعر متجذرة تجليها صفات يمكن إجمالها في قوة الدين وشدة التمسك به عقيدة وشريعة ومنظومة سلوك، في حرص على أداء الفروض والطاعات، والسعي إلى ما يشيع الخير والنفع ويذيع المحبة والسلام؛ مع إحساس بالذات في كبرياء وكرامة تحثان على الاعتزاز بالحرية والسيادة، وعلى التشبث بالعرض والشرف، وعلى رفض الذل والخنوع وعدم قبول الضيم والظلم، وعلى مقاومة كل ألوان التسلط والعدوان، وعلى مواجهة جميع التحديات بشجاعة وصبر وتحمل وتضحية بكل شيء، في سبيل الدفاع عن الوطن والحفاظ على كل ما هو فيه غال وعزيز ومقدس.
ثم إن المغاربة كانوا ـ وكما يدل على ذلك تاريخهم منذ القديم ـ ميالين إلى ما هو ملموس محسوس، وما هو صحيح قوي، وما هو مجد نافع، أكثر من ميلهم إلى سبر أغوار الحقائق وتذوق أشكال الجمال. ولعل السبب في ذلك راجع إلى موقعهم الجغرافي والظروف التي انبثقت من هذا الموقع، وما اضطرتهم إليه من مواقف التحدي المستمر والمواجهة الدائمة، وما نشأ عن هذا كله من تجارب، وما ولدت هذه التجارب من قيم عبرها كانوا ينظرون إلى الحياة والناس، أي كانوا من خلالها يكونون ذهنيتهم وفلسفتهم.
ومن هنا لا شك كان التمسك بالحرية مظهرا أساسيا من مظاهر هذه الفلسفة، بكل ما تفضي إليه الحرية من اعتزاز بالذات ورغبة في الاستقرار وفي السلام كذلك.
وإن هذه الملامح الخصوصية لتكشف عن ارتباط وثيق بالماضي، وتوق دائم إلى المجد الغابر والرغبة في تذكره واستحضاره وإحيائه، مما ينم عن متانة الأصول وما تجذر بها وتولد عنها من موروثات، كانت على الدوام بفضل تواصل حلقاتها المتماسكة تكيف واقع المغرب ووجوده ومنطق تاريخه.
إن البحث عن هذه الأصول لا يعني ارتماء في أحضان الماضي للتغني به أو الهروب إليه، لعجز عن مواجهة الحاضر والنظر إلى المستقبل، ولكنه يعني إدراكا واعيا للحاضر وتطلعا ملحا لاستشراف المستقبل، على أساس استخلاص هذه الأصول، باعتبارها مصدر الذات ومرجعها، ثم باعتبارها أسسا ودعائم يمكن الارتكاز عليها لمواصلة البناء الثقافي وتجديده وتقويته، بعيدا عما يعلوها من غبار، أو يخالطها من شوائب تراكمت عليها بفعل الزمن وشتى ظروفه ووقائعه.ثم إن تأمل هذه الأصول يفضي إلى إدراك حقيقة الثقافة المغربية، أي الثقافة الجامعة الموحدة التي تغتني بالروافد الفرعية كيفما كان نوعها وكانت محليتها، والتي بها يكون التجانس الذي يقوي الكيان.
ومتى قوي الكيان، تحقق استمرار الذات والإرادة، ومعه استمرار حق الإنسان في الحياة العزيزة الكريمة، واستمرار سموه على كل مظاهر الكون والطبيعة، واستمرار قدرته على مواجهة جميع التحديات التي تعترض
على أنه لا معنى لهذا التأمل في الأصول إن لم يقترن بالتمسك بها، لأن هذا التمسك هو الذي سيمكن المغرب من البقاء والقدرة على فرض هذا البقاء بكيان موحد وقوي، وهو الذي سيتيح له المساهمة في الثقافة الإنسانية، والنهوض فيها بدور فعال به يكون المغرب جديرا بحياة عزيزة كريمة وسط زوابع العصر وصراعاته وما يعتمل فيه من نزعات ونعرات .
وإن إثارة مثل هذا الموضوع ليكتسي بالغ الأهمية في المرحلة المعاصرة التي تعاني فيها الثقافة المغربية سلبيات تسربت من عهد الاستعمار، وفرضت عليها التقليص والعزلة والانكماش والتمزق والصراع مع غيرها،في قلق وحيرة وشك ونزاع داخل الذات والإرادة. وهي كلها ظواهر تفضي إلى التفكك الثقافي الذي لا يؤدي إلا إلى التخلف، والذي لا مخرج منه إلا بالتشبث بالثقافة في أصولها الثابتة، أي بثقافة مغربية عربية إسلامية.
إن التمسك بهذه الثقافة في أصولها المغربية العربية الإسلامية، وما يغني هذه الأصول من روافد مختلفة محلية أصيلة أو متسربة دخيلة، لهو الضمان للحفاظ على هوية المغرب وقوة كيانه وتميز شخصيته وتفرد ذاته. وضمن ذلك وبسببه يكون الحفاظ على وحدته الترابية والفكرية والشعورية؛ وهي الوحدة التي التحمت بنياتها على امتداد أربعة عشر قرنا بعفوية وتلقائية وبرباط مقدس متين.
وإن هذه الثقافة بكل مكوناتها وروافدها ومقوماتها ـ وفي طليعتها اللغة ـ ستبقى كما كانت هي لحمة التواصل بين جميع المنتسبين لأقطار العروبة، والأداة الحافزة لهم إلى لم الشمل وجمع الكلمة، والسلاح الذي به يستطيعون مواجهة كل التحديات التي تعترضهم، على الرغم من اختلاف أنظمة الحكم وما يتبعها من مذاهب سياسية واقتصادية
ثم إن هذه الثقافة بحمولتها الدينية وبلغتها القرآنية، هي أقوى رباط وأمتن وسيلة للتواصل بين شعوب الأمة الإسلامية، مهما تعددت انتماآتها الجنسية، وتنوعت ثقافاتها، وتباينت اتجاهاتها في شتى المجالات.
ويبقى في نهاية المطاف أن الهدف البعيد من إثارة قضية أصول الثقافة المغربية هو إبداع ثقافة تكون قادرة على أداء الوظيفة التي على كل ثقافة حية أن تؤديها وتتلخص متطلبات هذه الوظيفة في الآتي :
1 ـ ترسيخ الشعور بالهوية وتثبيته في اقتناع بها واعتزاز، وفي حرص عليها يقود إلى التمسك والتشبث بها والدفاع عنها والاستماتة من أجلها.
2 ـ تنمية الملكات وإغناء المؤهلات وتقوية القدرات بما يمكن من إمداد هذه الثقافة وتطويرها.
3 ـ الحث على ممارسة إنسانية المواطن ، أي بأداء واجباته،والتمتع بحقوقه،وإثبات حضوره،وإتاحة فرص المساهمة في تقدم الوطن، والإفادة من هذا التقدم بعدل وإنصاف.
4 ـ تحديد السلوك الفردي والجماعي ، وبلورة المفاهيم والقيم التي ينبني عليها هذا السلوك، والتي على أساسها تضبط الأفعال والانفعالات، وتقام العلاقات الخاصة والعامة بإدراك واع وحوار مفتوح.
5 ـ اعتبارها مرجعية منها يكون الانطلاق وإليها تكون العودة، مما تصبح به الموئل والملاذ في جميع الظروف والأحوال