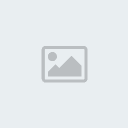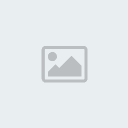1 هل يمكن إصلاح الولايات المتحدة؟ الجمعة فبراير 05, 2010 8:12 am
هل يمكن إصلاح الولايات المتحدة؟ الجمعة فبراير 05, 2010 8:12 am
doukkala
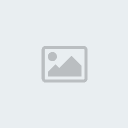
مشرف عام
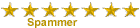
سيرج حليمي
سنة من حكم باراك أوباما
أحياناً تطفو الخلافات الشخصية والرفض الهوسي على سطح المعارك السياسية؛ فتولّد ضرورات المجابهة تجمّعات متنافرة تدفعها فقط الرغبة في تدمير ذات الهدف. لكن ما أن يسقط العدو أرضاً حتى تبدأ المتاعب؛ ومعها السؤال: ما العمل الآن؟ مع استعراض الخيارات السياسية، يجب رفع الالتباسات التي كانت تسهّل اتحاد المعارضين السابقين؛ وتسيطر الخيبة. هكذا لن يطول الزمن قبل عودة الخصم المكروه إلى السلطة. فإقامته في المعارضة لم تجعله سوى محبّباً أكثر.
هذا السيناريو شاهدناه في إيطاليا السيد سيلفيو برلوسكوني. فإذ هزمه في العام 1995 يسارٌ باهت ومتنافر وبلا مشروعٍ سياسي، عاد فائزاً من جديد بعد ستّة أعوام. في هذه الأثناء، وفي فرنسا السيد نيكولا ساركوزي أيضاً، تكاثرت التحالفات الظرفية، تارةً بين الأحزاب (أنصار البيئة والوسط والاشتراكيين) وتارةً بين الشخصيات (حيث تجاور السيد دومينيك دو فيلبان في نداءٍ مناهضٍ للحكومة مع السيد أوليفيه بيزانسينو المختلف عنه في كلّ شيء). هدفٌ واحد، هو رأس الدولة. جيّد، وماذا بعد؟
وفي مثّلث تحالف رفقة الطريق والسياسة المتردّدة والخيبة المبرمجة ما يذكّر أيضاً بيوميّات السياسة الأميركية الحاليّة. فقبل عام، سيطرت الفرحة مع هزيمة الجمهوريين ونهاية رئاسة السيد جورج والكر بوش. ولكن بالرغم من أنّ قسماً من الناخبين الذين لم يشهدوا تحسناً في أوضاعهم ما زالوا يؤيّدون السيد أوباما، فإنّ الحماسة تبدو وكأنّها قد أفلت. فتصاعد الحرب في أفغانستان يخيّب ظنون أنصار السلام ويبقى إصلاح النظام الصحي دون الطموحات المعقولة، كما هي حال السياسة البيئية. ويشيع الحكم القائل بأنّ ما تصنعه إدارة اوباما "أقلّ من جيّد، وأفضل من لا شيء"؛ وهذا يخلق جواً متجهّماً. هكذا تنتقل الحماسة السياسية مرّة أخرى من معسكرٍ إلى معسكر.
تؤكّد حلقة التقهقر هذه على وزن جماعات الضغط (اللوبيات) وتطرح السؤال حول السلطة الفعلية لرئيس الولايات المتحدة. من الواضح أنّ الرئيس الحالي ليس السيد بوش، كما لم يكن رومانو برودي أيضاً برلوسكوني. لكن هذا لا يكفي لمعرفة إلى أين سيتّجه السيد أوباما ولشحذ الرغبة على اللحاق به. فالبلد يعاني: حيث ارتفعت بقوّة نسبة البطالة، ووقعت منازل تؤلّف أحياءً بأكملها في حجز الدائنين. ولا يتوانى الرئيس عن الكلام والشرح ومحاولة الإقناع؛ وتتوالى خطبه ومنها البليغ. ولكن ماذا يبقى منها؟ إنّه يدين في القاهرة المستوطنات الإسرائيلية؛ ثمّ تشيّد مستوطنات جديدة فيرضخ. ويعِد بإصلاحٍ طموحٍ للنظام الصحّي؛ لكنّ النوّاب يخفّفون حجمه، فيرضى.
ثمّ يعلن ذات يوم أمام تلامذة كليّة "ويست بوينت" العسكريّة أنه سيرسل تعزيزات جديدة إلى أفغانستان؛ فيحصل بعد قليلٍ على جائزة نوبل للسلام. هكذا قد يقترب الأمر من الانفصام. لكن النشاز في المواقف يجد دواءه الظاهري في دفقٍ جديد من الكلمات يضع إزاء كلّ صياغةٍ احتمالاً معاكساً لها. وفي النهاية، تسيطر اللازمة: "أصدقائي التقدميّين يطالبون بكذا، وأصدقائي الجمهوريين يردّون بكذا. هؤلاء يطلبون الكثير، أولئك لا يقبلون كفاية. وأنا اختار الحلّ الوسط".
شجّع أوباما إذن خرّيجي "ويست بوينت" على "إبداء الاعتدال في استخدام القوة المسلّحة"، ودعا لجنة تحكيم جائزة نوبل في أوسلو إلى تقدير "ضرورات استخدام القوّة في وجه نواقص الإنسان وحدود العقل". وقد اضطرّ هؤلاء ايضاً إلى التأمّل في مثال الرئيس ريتشارد نيكسون الذي وافق، بالرغم من "فظائع الثورة الثقافية" على لقاء ماو تسي تونغ في بكين عام 1972. وكانت كلفة هذا اللقاء باهظة على هذا الرئيس الأميركي الجمهوري السابق الحريص على مسألة حقوق الانسان... بحيث أضطر ليعزّي نفسه أن يأمر، بعد وقتٍ قصير، بقصف المدن الفيتنامية الكبرى وتشجيع انقلاب الجنرال أوغستو بينوشيه في التشيلي. حول هذا، لا ينبس السيد أوباما ببنت شفة أمام أعضاء لجنة أوسلو. فهذا "الوسطي" الحريص قد فضّل توجيه التحية إلى ذكرى مارتن لوثر كينغ ورونالد ريغان... معاً.
مع أنّ كلّ شيءٍ كان قد بدأ بصورةٍ جيّدة. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وفد إلى صناديق الاقتراع ثلثَا الأميركيين الذين يحقّ لهم التصويت (و89.7 في المئة من المسجّلين على لوائح الاقتراع). فحملوا إلى البيت الأبيض مرشّحاً غير نمطيّ توحي مسيرته نفسها بحجم التغيير المتوقّع: "لا أتمتّع بالمواصفات المعهودة، ولم أمضِ حياتي في ردهات واشنطن". لهذا السبب تحديداً عرف كيف يعبّئ الشباب والسود وذوي الأصول الإسبانية، إضافةً إلى نسبة غير متوقّعة (43 في المئة) من الناخبين البيض. وإذ حصل على نسبة أصوات تفوق ما حصل عليه ريغان عند انتخابه عام 1980 (52.9 مقابل 50.7 في المئة)، فقد أمكن للسيد أوباما أن يمنّي النفس بـ"تفويضٍ" رئاسيّ حقيقي. على كلّ حال، لا أحد ينازعه ذلك؛ حيث جاءت هزيمة الجمهوريين كاملة. ولم يبقَ من فلسفتهم الليبرالية سوى الأسمال؛ فلسفةٌ اختصرها الرئيس الجديد بدقّة تعليميّة: "إعطاء المزيد لمن يملكون، على أمل أن يستفيد الجميع من إزدهارهم". كما حظي الديمقراطيّون بغالبيّة واسعة في مجلسّي الكونغرس.
وكان السيد أوباما قد وجّه تحذيراً قبل انتخابه بثلاثة أشهرٍ قائلاً: "أكبر خطر يداهمنا هو أن نلجأ إلى الأساليب السياسية نفسها، مع اللاعبين أنفسهم، وانتظار نتيجةٍ مختلفة منها. في مراحلٍ كهذه، يعلّمنا التاريخ أنّ التغيير لا يأتي من واشنطن، بل يصِل إلى واشنطن لأنّ الشعب الأميركي ينهض ويطالب به". يفترض إذن بالنضال على الأرض أن يسمح بزعزعة أثقال المحافظين في العاصمة، المركز الرسمي لكافّة مجموعات الضغط في البلاد. وبعد عام، وبينما لا نجد أثراً لأيّ حركةٍ شعبية، ولم تعُد تحصى القوانين المعطّلة والملطّفة والمبتورة عن طريق "الأساليب نفسها، واللاعبين أنفسهم".
لجهة المواصفات، كان الرئيس الحالي مختلف تماماً عن سابقيه؛ للسبب الظاهر المعروف، وأيضاً لأنّه من غير المعهود أن يدخل البيت الأبيض شخصٌ ضحّى في شبابه بفرصة كسب المال الكثير عبر ممارسة المحاماة في نيويورك، من أجل مساعدة سكان الأحياء الفقيرة في شيكاغو. لكن إذا ما فحصنا اختيار السيد أوباما لأعضاء حكومته، لا يبدو التجديد مذهلاً. فمقابل وزيرة للعمل مقرّبة من النقابات، السيدة هيلدا سوليس، التي تعد بقطيعة مع السياسات السابقة، نجد السيدة هيلاري كلنتون التي لا تعتبر توجهاتها الديبلوماسية بعيدة جداً عن الماضي، وأيضاً وزير الدفاع، السيد روبرت غيتس، الموروث بالكامل من إدارة بوش؛ أو أيضاً وزير المالية، السيد تيموثي غيتنر، المرتبط وثيقاً بـ"وال ستريت" بحيث يعجز (أو يرغب) حتّى في الإصلاح، ومستشاراً اقتصادياً، لورنس سامرز، كان مهندساً لسياسات نزع القيود المالية التي كلّفت البلاد الاقتراب من السكتة الدماغية. أما "تنوّع" الفريق فليس اجتماعياً؛ إذ أن 22 من أصل التعيينات الـ 35 الأولى التي أجراها السيد أوباما هي لأشخاصٍ يحملون شهادات من جامعات النخبة الأميركية أو من معهدٍ بريطاني رفيع المنزلة.
منذ مطلع القرن العشرين، يخضع الديموقراطيون للوهم التكنوقراط والكفاءات، وللبرغماتية ولحكم الأفضل ("الأفضل والألمع" the best and the brightest) وللتميّز والخبرة التي تفرض إرادتها على الوسط السياسي المتّهم بالديماغوجية الدائمة. المفارقة أنّ رئيس الولايات المتحدة، من جرّاء سيرته الذاتيّة (وكي لا ينظر إليه كمناضلٍ أفرو-أميركي)، يرتبط بفلسفةٍ من هذا النوع تنظر بعين الريبة إلى التحركات الجماهيرية و"الشعبوية". ومن البداية، أمل السيد أوباما أن توافقه الرأي الفئة الجمهورية الأكثر عقلانيةً لإخراج البلاد من الوحل. وقد مدّ لها يده، دون جدوى. وقد علّق مؤخراً على سؤ الاستقبال هذا بالقول: "اضطررنا لاتخاذ قرارات صعبة دون مساعدة الحزب المعارِض الذي قرّر، وللأسف، بعد أن قاد سياسات أوصلت البلاد إلى الأزمة، أن يرمي المسؤولية على الغير". صياغة غريبة لكنّها ذات مغزى كبير، فهي تتجاهل الانتخابات الرئاسية عام 2008 والتي لم "يقرّر" الجمهوريّون على أثرها ترك مقاليد الحكم للآخرين، بل طردوا من السلطة من قبل الشعب.
هم حتماً لا يتحمّلون هذا الطرد. ومن هنا عنفهم. ففي حزيران/يونيو من العام 1951، وصل الديموقراطي هاري ترومان إلى البيت الأبيض؛ وبدون تردد، كرّس نفسه لمحاربة الشيوعية والاتحاد السوفييتي والدفاع عن الأمبراطوريّة وأرباح "جنرال الكتريك". لكن ذلك لم يرقَ لقسمٍ كبير من الناخبين الجمهوريين، فاعتبروه خائناً، وهتف السيناتور جوزيف ماك كارثي: "لا يمكن فهم الوضع الحالي إن لم ندرك أن الأشخاص الموجودين في أعلى مراتب الدولة ينسّقون فيما بينهم لقيادتنا نحو الكارثة. إنّها مؤامرة من الضخامة بحيث لا تقيم أيّ وزنٍ يذكر لما سبقها في التاريخ. مؤامرة دنيئة بحيث يستحق المسؤول عنها، عند افتضاح أمره، أن يُلعن من كافّة الشرفاء". وطوال أربعة أعوام، سيزرع سيناتور ولاية ويسكونسن هذا الرعب في صفوف التقدميّين في البلاد، من فنانين ونقابيين وأيضاً من مسؤولين رئيسيين في الدولة، بمن فيهم العسكريين.
لم نصِل إلى هذا الحدّ. بيد أن الجوّ قد بات مسمماً بجنون عظمة المناضلين من اليمين، تهيّجهم المناظرات على الإذاعات و"الأخبار" المتواصلة على شبكة "فوكس نيوز" وافتتاحيات "وول ستريت جورنال" والكنائس الأصولية والشائعات الهاذية التي تبثّها شبكة الانترنت. ضجيجٌ يجتاح العقول ويحول دون التفكير في شيءٍ آخر. هكذا، لإن ملايين الأميركيين الشغوفين بالسياسة مقتنعون بأنّ رئيسهم قد كذب عليهم في أحواله الشخصيّة، وأنّه بحكم ولادته في الخارج لا يمكن انتخابه رئيساً. ويقسِمون بأنّ فوزه بفارق 8 ملايين و500 ألف صوت قد جاء نتيجة التزوير و"مؤامرة ضخمة...".
ينفرون من فكرة أن يقودهم رجلٌ أمضى عامَين في مدرسةٍ إسلامية في إندونيسيا، وهو مناضلٌ يساريّ سابق، وصاحب نزعة كوسموبوليتية، ومثقّف فوق ذلك [1]. وقناعتهم راسخة بأنّ إصلاح النظام الصحّي سيشكّل مدخلاً لـ "محاكمات الموت" المكلفة، أي إلى تحديد المرضى الجديرين بالعلاج. تشكل هذه الألوية الحامية الرؤوس النواة الصلبة للحزب الجمهوري. وهم يسيطرون على ممثّليهم الذي كان الوسطي أوباما يأمل التفاوض معهم حول سياسة إعادة النهوض وإصلاح النظام الصحّي وتقنين عالم المال.
وقد تأكّد دون تأخير عدم جدوى رجاءٍ من هذا النوع. فبعد أقلّ من شهر على دخول الرئيس الجديد البيت الأبيض، لم تحظَ خطّته لزيادة النفقات العامة على دعم أيّ من البرلمانيين الجمهوريين السبعة والسبعين في مجلس النواب. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، جاء دور إصلاح النظام الصحّي، حيث انضمّ هذه المرّة نائبٌ معارضٌ واحد إلى الغالبية الديموقراطية. وأخيراً في كانون الأول/ديسمبر، أقرّ مجلس النواب التشريعات المكرّسة لحماية المستهلكين دون تأييد أيّ عضوٍ جمهوريّ. ومع ذلك كانت النصوص المرفوعة تُعدّل في كلّ مرة على أمل أن تعطي الرئيس صورة المنفتح...
حول القطاع المالي، لا يعرف أحد ماذا سيكون القانون الذي سيوقّع عليه. ولكن يكفي في الواقع أن يلقى التصويت معارضة 40 من أعضاء مجلس الشيوخ كي تمتدّ المناقشة إلى ما لا نهاية. وبما أنّ عدد الجمهوريين يصِل إلى الأربعين، يمكن لأيّ منهم ولأيّ خائنٍ ديموقراطي أن يفاوض بالثمن العالي على موافقته. وأحد هؤلاء، السيد جوزيف ليبرمان (الذي كان دعا للتصويت للسيد جون ماك كاين عام 2008) قد أعاق قيام مؤسّسة ضمان حكوميّة (public option) يستفيد منها الأميركيون الذين لا يحظون بتغطيةٍ صحيّة. فشركات التأمين الخاصّة هي بين المموّلين الرئيسيين للسيناتور ليبرمان.
في 28 أيلول/سبتمبر 2008، وبينما كانت خطّة إنقاذ المصارف التي وافق عليها المرشّح أوباما ستمنحهم مساعدةً عاجلة بقيمة 700 مليار دولار، توجّه أحد النوّاب اليساريين، السيد دنيس كوسينيتش، إلى زملائه بالسؤال: "هل نحن كونغرس الولايات المتحدة أم مجلس إدارة غولدمان ساكس؟". بقي السؤال في محلّه، خاصّةً وأنّ الرئيس الأميركي وجد مفيداً أن يأتي بإيضاح: "لم أدخل الحملة الانتخابية لمساعدة أثرياء وول ستريت الكبار". مع ذلك، وفي العام 2008، كان كلّ من "غولدمان ساكس" و"سيتيغروب" و"جي بي مورغان" و"يو بي أس" و"مورغان ستانلي" في قائمة المموّلين العشرين الرئيسيّين لحملته الانتخابية [2]. بحيث يختصر الصحافي وليم غرايدر الوضع بجملةٍ واحدة: "يجد الديموقراطيّون أنفسهم أمام معضلة: هل يستطيعون خدمة المصلحة العامة دون إغضاب أصحاب المصارف الذين يموّلون سيرتهم الذاتيّة؟ [3]".
فهل الولايات المتحدة قابلة إذاً للإصلاح؟ هناك ادّعاء بأن نظامها السياسيّ يتميّز بـ"توزان السلطات"؛ ولكنّه يقوم في الواقع على تكاثر المستويات التي يتحكّم الدولار بها. وفي العام 2008، انطلق ملايين الشبّان في معركةٍ سياسيّة على أمل أنّ الأمور لن تعود كالسابق مع الرئيس الجديد. لكن ها هو أيضاً يتصرّف كسمسار، ويشتري صوتاً ينقصه، ويغازل نائباً يحتقره. ولكن هل من بديلٍ عن ذلك؟ لا تصمد شخصية رجل كثيراً أمام تحكّم المؤسّسات، خصوصاً عندما تظهر "الهستيريا" على المعارضة، وتُختصر "الحركة الشعبية" بنقابات مدجّنة ومناضلين سود تتبنّاهم السلطة التنفيذية ومحرّري مدوّنات الكترونية مزهوّين بأنفسهم، يعتقدون أنّ النضال يتفتح من خلف لوحة المفاتيح. ففي الولايات المتحدة، يتطلّب إضفاء المنحى التقدميّ على الأمور اصطفافاً شبه تامٍ للكواكب. وفي المقابل، ومن أجل خفض الضرائب على الأغنياء، لم يحتاج ريغان إلى غالبية نوابٍ جمهوريين...
لقد خلقت سيرة حياة السيّد أوباما سؤ تفاهم. لأنّها من جهة ركّزت عليه كل العيون الفاحصة وكل الانتظارات؛ ومن جهة أخرى، لأنّ رئيس الولايات المتحدة لم يعُد منذ زمنٍ طويل يشبه المراهق الراديكالي الذي يصفه في مذكّراته. ذاك الذي كان يأتي إلى المحاضرات الاشتراكية وينشط في حيّ هارلم ضمن جمعيةٍ قريبة من السيد رالف نادر. ولم يعُد فيه الكثير من المناضل الأفرو-أميركي الذي "بغية تفادي نعته بالخائن، قد اختار اصدقائه بعناية: الطلاّب السود الأكثر نشاطاً؛ "التشيكانوس"، من الأميركيين من أصل مكسيكي؛ والأساتذة الماركسيين؛ والبنيويين المؤيدين لحقوق المرأة وشعراء موسيقى "البنك روك". كنّا ندخن السجائر ونرتدي سترات الجلد الأسود. وفي الليل، داخل المهاجع، نتناقش حول الاستعمار الجديد وفرانتز فانون والمركزية الثقافية الأوروبية والنظام البطريركي [4]".
بالنسبة للجمهوريين، يُظهر هذا الماضي أن الرجل خطير، وغريبٌ عن ثقافة البلاد الفرديّة، متساهل مع "أعداء الحريّة" ومستعدّ، بداية، "لتحويل نظام الصحّة الأميركي نحو الاشتراكية". من جهتهم، يأمل قسمٌ من المناضلين الديموقراطيين الخائبين منه حالياً، ألاّ يتردّد عندما تسنح له الفرصة في انتهاج سياسةٍ أكثر تقدميّة، وأنّ هذا ما يريده فعلاً. بحيث يعزّز تشكيك هذه الفئة آمال الفئة الثانية. بيد أن اليسار، الذي يتفحّص أحشاء النصوص المحالة على الكونغرس ليعثر فيها على أثر لانتصار، يعرف، في استرجاعٍ لعبارة الصحافي الكسندر كوكبرن، أنّ الوقت محسوب: حيث أنّ انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل التشريعية قد تجري في مناخٍ اقتصاديّ قاتم، ربما سيقلّص من عدد النواب الديموقراطيين.
في النهاية هناك إفراطٌ في الحديث عن السيّد أوباما. فقد اتّخذ الرجل وجه صانع المعجزات القادر على ترويض القوى الاجتماعية والمؤسّسات والمصالح. حيث تميّز هذه الشخصنة غير الناضجة للسلطة أيضاً فرنسا وإيطاليا؛ لكنّ الشيطان يكمُن في المقلب الآخر: أن يسقط، فيتمّ إنقاذ البلاد... وقبل نصف قرن، روّج المؤرخ الأميركي ريتشارد هوفستادتير لعبارة "الأسلوب الخيلائي" style paranoïaque للتعبير عن مزاجٍ سياسيّ من هذا النوع. وكان يفكّر عندها باليمين المكارثيّ وبدائله المباشرة، لكنّه كان يدّعي أيضاً أن نموذجه المثالي سيجد عبر السنين تجليّات أخرى.
ها قد وصلنا إلى ذلك. فقد عمّم ازدهار الفردية والكسل الفكري والانجراف الهستيري للنقاشات والدور الضارّ للإعلام، وتداعي الماركسية أيضاً، الوهم القائل، بحسب تفسير هورفستاردتير عام 1963، أنّ "العدو، وخلافاً لنا جميعاً، لا يخضع لآليّة التاريخ الكبرى وليس ضحيّة ماضيه ورغباته وحدوده. إنّه فاعلٌ حرّ، نشيطٌ وشيطاني (...) يفبرك الأزمات، ويتسبّب بالأزمات المصرفية والانهيار الاقتصادي، ويصنّع الكوارث ويتلذّذ من ثمّ بها مستفيداً من البؤس الذي أحدثه [5]". يردّ أحد مذيعي الراديو من المحافظين المتطرّفين، روش ليمبو، بأنّ بعض أنصار أوباما يعتبرونه المسيح. ليس مخطئاً، لكن لماذا يثابر يومياً على التشهير بالمسيح الدجّال؟
إن "معجزة" انتخاب تشرين الثاني/نوفمبر 2008 كانت ربما لتذكيرنا بأن لا وجود للمعجزات. وأنّ مصير الولايات المتحدة لا يتماهى لا مع شخصيّة رجل، ولا مع إرادة رئيس.
1] اقرأ: سيرج حليمي: "خطّة اليمين الأميركي: تعبئة الشعب ضدّ المثقّفين"، لوموند ديبلوماتيك النشرة العربية، ايار/مايو 2006؛ http://www.mondiploar.com/article47...
[2] وفق اللائحة التي أعدّها مركز Center for Responsive Politics http://www.opensecrets.org/pres08/c...
[3] راجع: وليام غريدر "رجل المال افضل صديق"، مجلّة "The Nation"، نيويورك، 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
[4] Barack Obama, Dreams from My Father, Three Rivers Press, New york, 2004, p. 100.
[5] Richard Hofstadter, The Paranoid Style in American Politics, Alfred Knopf, New York, 1966, p. 3
سنة من حكم باراك أوباما
أحياناً تطفو الخلافات الشخصية والرفض الهوسي على سطح المعارك السياسية؛ فتولّد ضرورات المجابهة تجمّعات متنافرة تدفعها فقط الرغبة في تدمير ذات الهدف. لكن ما أن يسقط العدو أرضاً حتى تبدأ المتاعب؛ ومعها السؤال: ما العمل الآن؟ مع استعراض الخيارات السياسية، يجب رفع الالتباسات التي كانت تسهّل اتحاد المعارضين السابقين؛ وتسيطر الخيبة. هكذا لن يطول الزمن قبل عودة الخصم المكروه إلى السلطة. فإقامته في المعارضة لم تجعله سوى محبّباً أكثر.
هذا السيناريو شاهدناه في إيطاليا السيد سيلفيو برلوسكوني. فإذ هزمه في العام 1995 يسارٌ باهت ومتنافر وبلا مشروعٍ سياسي، عاد فائزاً من جديد بعد ستّة أعوام. في هذه الأثناء، وفي فرنسا السيد نيكولا ساركوزي أيضاً، تكاثرت التحالفات الظرفية، تارةً بين الأحزاب (أنصار البيئة والوسط والاشتراكيين) وتارةً بين الشخصيات (حيث تجاور السيد دومينيك دو فيلبان في نداءٍ مناهضٍ للحكومة مع السيد أوليفيه بيزانسينو المختلف عنه في كلّ شيء). هدفٌ واحد، هو رأس الدولة. جيّد، وماذا بعد؟
وفي مثّلث تحالف رفقة الطريق والسياسة المتردّدة والخيبة المبرمجة ما يذكّر أيضاً بيوميّات السياسة الأميركية الحاليّة. فقبل عام، سيطرت الفرحة مع هزيمة الجمهوريين ونهاية رئاسة السيد جورج والكر بوش. ولكن بالرغم من أنّ قسماً من الناخبين الذين لم يشهدوا تحسناً في أوضاعهم ما زالوا يؤيّدون السيد أوباما، فإنّ الحماسة تبدو وكأنّها قد أفلت. فتصاعد الحرب في أفغانستان يخيّب ظنون أنصار السلام ويبقى إصلاح النظام الصحي دون الطموحات المعقولة، كما هي حال السياسة البيئية. ويشيع الحكم القائل بأنّ ما تصنعه إدارة اوباما "أقلّ من جيّد، وأفضل من لا شيء"؛ وهذا يخلق جواً متجهّماً. هكذا تنتقل الحماسة السياسية مرّة أخرى من معسكرٍ إلى معسكر.
تؤكّد حلقة التقهقر هذه على وزن جماعات الضغط (اللوبيات) وتطرح السؤال حول السلطة الفعلية لرئيس الولايات المتحدة. من الواضح أنّ الرئيس الحالي ليس السيد بوش، كما لم يكن رومانو برودي أيضاً برلوسكوني. لكن هذا لا يكفي لمعرفة إلى أين سيتّجه السيد أوباما ولشحذ الرغبة على اللحاق به. فالبلد يعاني: حيث ارتفعت بقوّة نسبة البطالة، ووقعت منازل تؤلّف أحياءً بأكملها في حجز الدائنين. ولا يتوانى الرئيس عن الكلام والشرح ومحاولة الإقناع؛ وتتوالى خطبه ومنها البليغ. ولكن ماذا يبقى منها؟ إنّه يدين في القاهرة المستوطنات الإسرائيلية؛ ثمّ تشيّد مستوطنات جديدة فيرضخ. ويعِد بإصلاحٍ طموحٍ للنظام الصحّي؛ لكنّ النوّاب يخفّفون حجمه، فيرضى.
ثمّ يعلن ذات يوم أمام تلامذة كليّة "ويست بوينت" العسكريّة أنه سيرسل تعزيزات جديدة إلى أفغانستان؛ فيحصل بعد قليلٍ على جائزة نوبل للسلام. هكذا قد يقترب الأمر من الانفصام. لكن النشاز في المواقف يجد دواءه الظاهري في دفقٍ جديد من الكلمات يضع إزاء كلّ صياغةٍ احتمالاً معاكساً لها. وفي النهاية، تسيطر اللازمة: "أصدقائي التقدميّين يطالبون بكذا، وأصدقائي الجمهوريين يردّون بكذا. هؤلاء يطلبون الكثير، أولئك لا يقبلون كفاية. وأنا اختار الحلّ الوسط".
شجّع أوباما إذن خرّيجي "ويست بوينت" على "إبداء الاعتدال في استخدام القوة المسلّحة"، ودعا لجنة تحكيم جائزة نوبل في أوسلو إلى تقدير "ضرورات استخدام القوّة في وجه نواقص الإنسان وحدود العقل". وقد اضطرّ هؤلاء ايضاً إلى التأمّل في مثال الرئيس ريتشارد نيكسون الذي وافق، بالرغم من "فظائع الثورة الثقافية" على لقاء ماو تسي تونغ في بكين عام 1972. وكانت كلفة هذا اللقاء باهظة على هذا الرئيس الأميركي الجمهوري السابق الحريص على مسألة حقوق الانسان... بحيث أضطر ليعزّي نفسه أن يأمر، بعد وقتٍ قصير، بقصف المدن الفيتنامية الكبرى وتشجيع انقلاب الجنرال أوغستو بينوشيه في التشيلي. حول هذا، لا ينبس السيد أوباما ببنت شفة أمام أعضاء لجنة أوسلو. فهذا "الوسطي" الحريص قد فضّل توجيه التحية إلى ذكرى مارتن لوثر كينغ ورونالد ريغان... معاً.
مع أنّ كلّ شيءٍ كان قد بدأ بصورةٍ جيّدة. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وفد إلى صناديق الاقتراع ثلثَا الأميركيين الذين يحقّ لهم التصويت (و89.7 في المئة من المسجّلين على لوائح الاقتراع). فحملوا إلى البيت الأبيض مرشّحاً غير نمطيّ توحي مسيرته نفسها بحجم التغيير المتوقّع: "لا أتمتّع بالمواصفات المعهودة، ولم أمضِ حياتي في ردهات واشنطن". لهذا السبب تحديداً عرف كيف يعبّئ الشباب والسود وذوي الأصول الإسبانية، إضافةً إلى نسبة غير متوقّعة (43 في المئة) من الناخبين البيض. وإذ حصل على نسبة أصوات تفوق ما حصل عليه ريغان عند انتخابه عام 1980 (52.9 مقابل 50.7 في المئة)، فقد أمكن للسيد أوباما أن يمنّي النفس بـ"تفويضٍ" رئاسيّ حقيقي. على كلّ حال، لا أحد ينازعه ذلك؛ حيث جاءت هزيمة الجمهوريين كاملة. ولم يبقَ من فلسفتهم الليبرالية سوى الأسمال؛ فلسفةٌ اختصرها الرئيس الجديد بدقّة تعليميّة: "إعطاء المزيد لمن يملكون، على أمل أن يستفيد الجميع من إزدهارهم". كما حظي الديمقراطيّون بغالبيّة واسعة في مجلسّي الكونغرس.
وكان السيد أوباما قد وجّه تحذيراً قبل انتخابه بثلاثة أشهرٍ قائلاً: "أكبر خطر يداهمنا هو أن نلجأ إلى الأساليب السياسية نفسها، مع اللاعبين أنفسهم، وانتظار نتيجةٍ مختلفة منها. في مراحلٍ كهذه، يعلّمنا التاريخ أنّ التغيير لا يأتي من واشنطن، بل يصِل إلى واشنطن لأنّ الشعب الأميركي ينهض ويطالب به". يفترض إذن بالنضال على الأرض أن يسمح بزعزعة أثقال المحافظين في العاصمة، المركز الرسمي لكافّة مجموعات الضغط في البلاد. وبعد عام، وبينما لا نجد أثراً لأيّ حركةٍ شعبية، ولم تعُد تحصى القوانين المعطّلة والملطّفة والمبتورة عن طريق "الأساليب نفسها، واللاعبين أنفسهم".
لجهة المواصفات، كان الرئيس الحالي مختلف تماماً عن سابقيه؛ للسبب الظاهر المعروف، وأيضاً لأنّه من غير المعهود أن يدخل البيت الأبيض شخصٌ ضحّى في شبابه بفرصة كسب المال الكثير عبر ممارسة المحاماة في نيويورك، من أجل مساعدة سكان الأحياء الفقيرة في شيكاغو. لكن إذا ما فحصنا اختيار السيد أوباما لأعضاء حكومته، لا يبدو التجديد مذهلاً. فمقابل وزيرة للعمل مقرّبة من النقابات، السيدة هيلدا سوليس، التي تعد بقطيعة مع السياسات السابقة، نجد السيدة هيلاري كلنتون التي لا تعتبر توجهاتها الديبلوماسية بعيدة جداً عن الماضي، وأيضاً وزير الدفاع، السيد روبرت غيتس، الموروث بالكامل من إدارة بوش؛ أو أيضاً وزير المالية، السيد تيموثي غيتنر، المرتبط وثيقاً بـ"وال ستريت" بحيث يعجز (أو يرغب) حتّى في الإصلاح، ومستشاراً اقتصادياً، لورنس سامرز، كان مهندساً لسياسات نزع القيود المالية التي كلّفت البلاد الاقتراب من السكتة الدماغية. أما "تنوّع" الفريق فليس اجتماعياً؛ إذ أن 22 من أصل التعيينات الـ 35 الأولى التي أجراها السيد أوباما هي لأشخاصٍ يحملون شهادات من جامعات النخبة الأميركية أو من معهدٍ بريطاني رفيع المنزلة.
منذ مطلع القرن العشرين، يخضع الديموقراطيون للوهم التكنوقراط والكفاءات، وللبرغماتية ولحكم الأفضل ("الأفضل والألمع" the best and the brightest) وللتميّز والخبرة التي تفرض إرادتها على الوسط السياسي المتّهم بالديماغوجية الدائمة. المفارقة أنّ رئيس الولايات المتحدة، من جرّاء سيرته الذاتيّة (وكي لا ينظر إليه كمناضلٍ أفرو-أميركي)، يرتبط بفلسفةٍ من هذا النوع تنظر بعين الريبة إلى التحركات الجماهيرية و"الشعبوية". ومن البداية، أمل السيد أوباما أن توافقه الرأي الفئة الجمهورية الأكثر عقلانيةً لإخراج البلاد من الوحل. وقد مدّ لها يده، دون جدوى. وقد علّق مؤخراً على سؤ الاستقبال هذا بالقول: "اضطررنا لاتخاذ قرارات صعبة دون مساعدة الحزب المعارِض الذي قرّر، وللأسف، بعد أن قاد سياسات أوصلت البلاد إلى الأزمة، أن يرمي المسؤولية على الغير". صياغة غريبة لكنّها ذات مغزى كبير، فهي تتجاهل الانتخابات الرئاسية عام 2008 والتي لم "يقرّر" الجمهوريّون على أثرها ترك مقاليد الحكم للآخرين، بل طردوا من السلطة من قبل الشعب.
هم حتماً لا يتحمّلون هذا الطرد. ومن هنا عنفهم. ففي حزيران/يونيو من العام 1951، وصل الديموقراطي هاري ترومان إلى البيت الأبيض؛ وبدون تردد، كرّس نفسه لمحاربة الشيوعية والاتحاد السوفييتي والدفاع عن الأمبراطوريّة وأرباح "جنرال الكتريك". لكن ذلك لم يرقَ لقسمٍ كبير من الناخبين الجمهوريين، فاعتبروه خائناً، وهتف السيناتور جوزيف ماك كارثي: "لا يمكن فهم الوضع الحالي إن لم ندرك أن الأشخاص الموجودين في أعلى مراتب الدولة ينسّقون فيما بينهم لقيادتنا نحو الكارثة. إنّها مؤامرة من الضخامة بحيث لا تقيم أيّ وزنٍ يذكر لما سبقها في التاريخ. مؤامرة دنيئة بحيث يستحق المسؤول عنها، عند افتضاح أمره، أن يُلعن من كافّة الشرفاء". وطوال أربعة أعوام، سيزرع سيناتور ولاية ويسكونسن هذا الرعب في صفوف التقدميّين في البلاد، من فنانين ونقابيين وأيضاً من مسؤولين رئيسيين في الدولة، بمن فيهم العسكريين.
لم نصِل إلى هذا الحدّ. بيد أن الجوّ قد بات مسمماً بجنون عظمة المناضلين من اليمين، تهيّجهم المناظرات على الإذاعات و"الأخبار" المتواصلة على شبكة "فوكس نيوز" وافتتاحيات "وول ستريت جورنال" والكنائس الأصولية والشائعات الهاذية التي تبثّها شبكة الانترنت. ضجيجٌ يجتاح العقول ويحول دون التفكير في شيءٍ آخر. هكذا، لإن ملايين الأميركيين الشغوفين بالسياسة مقتنعون بأنّ رئيسهم قد كذب عليهم في أحواله الشخصيّة، وأنّه بحكم ولادته في الخارج لا يمكن انتخابه رئيساً. ويقسِمون بأنّ فوزه بفارق 8 ملايين و500 ألف صوت قد جاء نتيجة التزوير و"مؤامرة ضخمة...".
ينفرون من فكرة أن يقودهم رجلٌ أمضى عامَين في مدرسةٍ إسلامية في إندونيسيا، وهو مناضلٌ يساريّ سابق، وصاحب نزعة كوسموبوليتية، ومثقّف فوق ذلك [1]. وقناعتهم راسخة بأنّ إصلاح النظام الصحّي سيشكّل مدخلاً لـ "محاكمات الموت" المكلفة، أي إلى تحديد المرضى الجديرين بالعلاج. تشكل هذه الألوية الحامية الرؤوس النواة الصلبة للحزب الجمهوري. وهم يسيطرون على ممثّليهم الذي كان الوسطي أوباما يأمل التفاوض معهم حول سياسة إعادة النهوض وإصلاح النظام الصحّي وتقنين عالم المال.
وقد تأكّد دون تأخير عدم جدوى رجاءٍ من هذا النوع. فبعد أقلّ من شهر على دخول الرئيس الجديد البيت الأبيض، لم تحظَ خطّته لزيادة النفقات العامة على دعم أيّ من البرلمانيين الجمهوريين السبعة والسبعين في مجلس النواب. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، جاء دور إصلاح النظام الصحّي، حيث انضمّ هذه المرّة نائبٌ معارضٌ واحد إلى الغالبية الديموقراطية. وأخيراً في كانون الأول/ديسمبر، أقرّ مجلس النواب التشريعات المكرّسة لحماية المستهلكين دون تأييد أيّ عضوٍ جمهوريّ. ومع ذلك كانت النصوص المرفوعة تُعدّل في كلّ مرة على أمل أن تعطي الرئيس صورة المنفتح...
حول القطاع المالي، لا يعرف أحد ماذا سيكون القانون الذي سيوقّع عليه. ولكن يكفي في الواقع أن يلقى التصويت معارضة 40 من أعضاء مجلس الشيوخ كي تمتدّ المناقشة إلى ما لا نهاية. وبما أنّ عدد الجمهوريين يصِل إلى الأربعين، يمكن لأيّ منهم ولأيّ خائنٍ ديموقراطي أن يفاوض بالثمن العالي على موافقته. وأحد هؤلاء، السيد جوزيف ليبرمان (الذي كان دعا للتصويت للسيد جون ماك كاين عام 2008) قد أعاق قيام مؤسّسة ضمان حكوميّة (public option) يستفيد منها الأميركيون الذين لا يحظون بتغطيةٍ صحيّة. فشركات التأمين الخاصّة هي بين المموّلين الرئيسيين للسيناتور ليبرمان.
في 28 أيلول/سبتمبر 2008، وبينما كانت خطّة إنقاذ المصارف التي وافق عليها المرشّح أوباما ستمنحهم مساعدةً عاجلة بقيمة 700 مليار دولار، توجّه أحد النوّاب اليساريين، السيد دنيس كوسينيتش، إلى زملائه بالسؤال: "هل نحن كونغرس الولايات المتحدة أم مجلس إدارة غولدمان ساكس؟". بقي السؤال في محلّه، خاصّةً وأنّ الرئيس الأميركي وجد مفيداً أن يأتي بإيضاح: "لم أدخل الحملة الانتخابية لمساعدة أثرياء وول ستريت الكبار". مع ذلك، وفي العام 2008، كان كلّ من "غولدمان ساكس" و"سيتيغروب" و"جي بي مورغان" و"يو بي أس" و"مورغان ستانلي" في قائمة المموّلين العشرين الرئيسيّين لحملته الانتخابية [2]. بحيث يختصر الصحافي وليم غرايدر الوضع بجملةٍ واحدة: "يجد الديموقراطيّون أنفسهم أمام معضلة: هل يستطيعون خدمة المصلحة العامة دون إغضاب أصحاب المصارف الذين يموّلون سيرتهم الذاتيّة؟ [3]".
فهل الولايات المتحدة قابلة إذاً للإصلاح؟ هناك ادّعاء بأن نظامها السياسيّ يتميّز بـ"توزان السلطات"؛ ولكنّه يقوم في الواقع على تكاثر المستويات التي يتحكّم الدولار بها. وفي العام 2008، انطلق ملايين الشبّان في معركةٍ سياسيّة على أمل أنّ الأمور لن تعود كالسابق مع الرئيس الجديد. لكن ها هو أيضاً يتصرّف كسمسار، ويشتري صوتاً ينقصه، ويغازل نائباً يحتقره. ولكن هل من بديلٍ عن ذلك؟ لا تصمد شخصية رجل كثيراً أمام تحكّم المؤسّسات، خصوصاً عندما تظهر "الهستيريا" على المعارضة، وتُختصر "الحركة الشعبية" بنقابات مدجّنة ومناضلين سود تتبنّاهم السلطة التنفيذية ومحرّري مدوّنات الكترونية مزهوّين بأنفسهم، يعتقدون أنّ النضال يتفتح من خلف لوحة المفاتيح. ففي الولايات المتحدة، يتطلّب إضفاء المنحى التقدميّ على الأمور اصطفافاً شبه تامٍ للكواكب. وفي المقابل، ومن أجل خفض الضرائب على الأغنياء، لم يحتاج ريغان إلى غالبية نوابٍ جمهوريين...
لقد خلقت سيرة حياة السيّد أوباما سؤ تفاهم. لأنّها من جهة ركّزت عليه كل العيون الفاحصة وكل الانتظارات؛ ومن جهة أخرى، لأنّ رئيس الولايات المتحدة لم يعُد منذ زمنٍ طويل يشبه المراهق الراديكالي الذي يصفه في مذكّراته. ذاك الذي كان يأتي إلى المحاضرات الاشتراكية وينشط في حيّ هارلم ضمن جمعيةٍ قريبة من السيد رالف نادر. ولم يعُد فيه الكثير من المناضل الأفرو-أميركي الذي "بغية تفادي نعته بالخائن، قد اختار اصدقائه بعناية: الطلاّب السود الأكثر نشاطاً؛ "التشيكانوس"، من الأميركيين من أصل مكسيكي؛ والأساتذة الماركسيين؛ والبنيويين المؤيدين لحقوق المرأة وشعراء موسيقى "البنك روك". كنّا ندخن السجائر ونرتدي سترات الجلد الأسود. وفي الليل، داخل المهاجع، نتناقش حول الاستعمار الجديد وفرانتز فانون والمركزية الثقافية الأوروبية والنظام البطريركي [4]".
بالنسبة للجمهوريين، يُظهر هذا الماضي أن الرجل خطير، وغريبٌ عن ثقافة البلاد الفرديّة، متساهل مع "أعداء الحريّة" ومستعدّ، بداية، "لتحويل نظام الصحّة الأميركي نحو الاشتراكية". من جهتهم، يأمل قسمٌ من المناضلين الديموقراطيين الخائبين منه حالياً، ألاّ يتردّد عندما تسنح له الفرصة في انتهاج سياسةٍ أكثر تقدميّة، وأنّ هذا ما يريده فعلاً. بحيث يعزّز تشكيك هذه الفئة آمال الفئة الثانية. بيد أن اليسار، الذي يتفحّص أحشاء النصوص المحالة على الكونغرس ليعثر فيها على أثر لانتصار، يعرف، في استرجاعٍ لعبارة الصحافي الكسندر كوكبرن، أنّ الوقت محسوب: حيث أنّ انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل التشريعية قد تجري في مناخٍ اقتصاديّ قاتم، ربما سيقلّص من عدد النواب الديموقراطيين.
في النهاية هناك إفراطٌ في الحديث عن السيّد أوباما. فقد اتّخذ الرجل وجه صانع المعجزات القادر على ترويض القوى الاجتماعية والمؤسّسات والمصالح. حيث تميّز هذه الشخصنة غير الناضجة للسلطة أيضاً فرنسا وإيطاليا؛ لكنّ الشيطان يكمُن في المقلب الآخر: أن يسقط، فيتمّ إنقاذ البلاد... وقبل نصف قرن، روّج المؤرخ الأميركي ريتشارد هوفستادتير لعبارة "الأسلوب الخيلائي" style paranoïaque للتعبير عن مزاجٍ سياسيّ من هذا النوع. وكان يفكّر عندها باليمين المكارثيّ وبدائله المباشرة، لكنّه كان يدّعي أيضاً أن نموذجه المثالي سيجد عبر السنين تجليّات أخرى.
ها قد وصلنا إلى ذلك. فقد عمّم ازدهار الفردية والكسل الفكري والانجراف الهستيري للنقاشات والدور الضارّ للإعلام، وتداعي الماركسية أيضاً، الوهم القائل، بحسب تفسير هورفستاردتير عام 1963، أنّ "العدو، وخلافاً لنا جميعاً، لا يخضع لآليّة التاريخ الكبرى وليس ضحيّة ماضيه ورغباته وحدوده. إنّه فاعلٌ حرّ، نشيطٌ وشيطاني (...) يفبرك الأزمات، ويتسبّب بالأزمات المصرفية والانهيار الاقتصادي، ويصنّع الكوارث ويتلذّذ من ثمّ بها مستفيداً من البؤس الذي أحدثه [5]". يردّ أحد مذيعي الراديو من المحافظين المتطرّفين، روش ليمبو، بأنّ بعض أنصار أوباما يعتبرونه المسيح. ليس مخطئاً، لكن لماذا يثابر يومياً على التشهير بالمسيح الدجّال؟
إن "معجزة" انتخاب تشرين الثاني/نوفمبر 2008 كانت ربما لتذكيرنا بأن لا وجود للمعجزات. وأنّ مصير الولايات المتحدة لا يتماهى لا مع شخصيّة رجل، ولا مع إرادة رئيس.
1] اقرأ: سيرج حليمي: "خطّة اليمين الأميركي: تعبئة الشعب ضدّ المثقّفين"، لوموند ديبلوماتيك النشرة العربية، ايار/مايو 2006؛ http://www.mondiploar.com/article47...
[2] وفق اللائحة التي أعدّها مركز Center for Responsive Politics http://www.opensecrets.org/pres08/c...
[3] راجع: وليام غريدر "رجل المال افضل صديق"، مجلّة "The Nation"، نيويورك، 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
[4] Barack Obama, Dreams from My Father, Three Rivers Press, New york, 2004, p. 100.
[5] Richard Hofstadter, The Paranoid Style in American Politics, Alfred Knopf, New York, 1966, p. 3